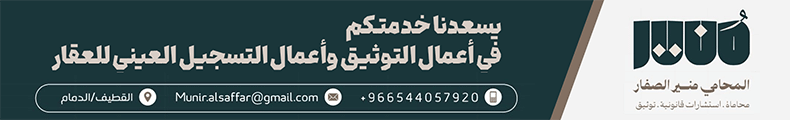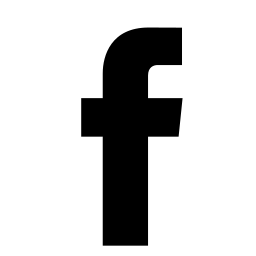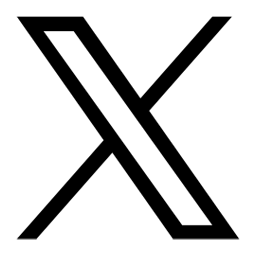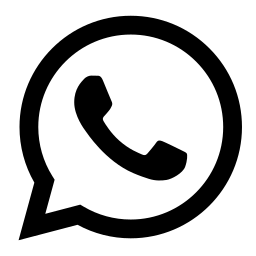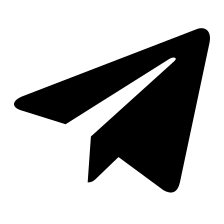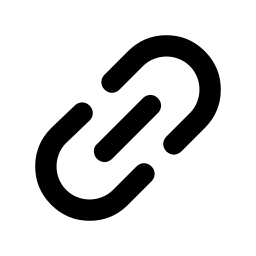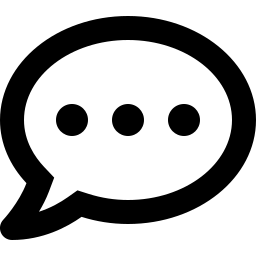رسالةُ وداعٍ أخيرة
يملك الصغار عادةً تصنيفاً خاصاً لأولئك الكبار الذين يُحسنون التعامل معهم، إذ تسود لدى نسبة غير قليلة من الناس قناعةٌ خاطئة ترى أن احترام الصغار ومخاطبتهم بودّ يتنافى مع الهيبة والوقار. ونتيجةً لذلك، يتجهم بعضهم في حديثه مع الأطفال، وقد يعاملهم بجفاء أو يترفع حتى عن السلام عليهم. ضمن هذا المشهد الاجتماعي، يبرز في ذهني منذ طفولتي وبوضوح ابن العم المرحوم الحاج علي عبد الكريم أبو السعود، ضمن أولئك النفر القلائل المتمردين على هذا السلوك المتخلف؛ هكذا عرفه الجميع طيباً محباً للصغير قبل الكبير، ودوداً بالغ الإحترام معهم.
حقيقةُ الحياةِ منهِكة، وفي الغالب لا يخلو إنسانٌ من همومٍ وغمومٍ ومشاكلَ منغِّصة، ولا يكاد يخلو تبعاً لذلك من مواقفَ تشوبها ضغائن، أو شيءٌ من الأحقاد، أو لحظاتِ غضبٍ تجاه الآخرين. ولهذا تبدو تلك أسباباً كافيةً لأن نلحظ على الوجوه ملامحَ شتى؛ تارةً بالسعادة والإيجابية، وتارةً بالانقباض وربما الغضب. المرحوم الحاج علي، فيما أظن، كان باطنُه كظاهرِه؛ فمن الصعب أن تجده متجهماً أو تبدو عليه ملامحُ العداء والضغينة لأحد. وبتعبيرنا الدارج، كان «ماءً بارداً على القلب». وحين يكون الإنسان ملتهباً، كما هي حالنا مع مشاق الحياة وتقلباتها، فإن هذا النموذج الطيب من البشر يكون غالباً مصدرَ سكينةٍ وطمأنينةٍ لمن حوله، وهي صفاتٌ نحتاجها كثيراً لنتمكن من تجاوز منغصات هذه الحياة وآلامها. والحديث لا بدّ له أن يصل، شئنا أم أبينا، إلى ذلك العنوان البارز - في شخصيته - من التواصل الذي جعل منه عنصراً واضحاً في أفراح الناس وأتراحهم. لقد كان وصولاً بما يكفي ليجعل حضوره أمراً جلياً في كل مناسبة؛ في عيادة مريض، أو صلة رحم، أو فرح، أو حزن. وحتى في عالم الإدارة، ذلك العالم الذي قلّما تجد فيه موظفاً يمنح مسؤولاً تقييماً عالياً، فإن أبا حسن كان من أولئك القلائل الذين أحبّهم جميع الموظفين، اعترافاً منهم بإنسانيته قبل أي شيء آخر.
لقد أرسل لي المرحوم دعوةً لحضور حفل زفاف ابن أخته، وبحكم عملي في الرياض، فإن ضيق الوقت في القطيف غالباً ما يحول بيني وبين المشاركة في المناسبات الاجتماعية. غير أن الدعوة حين تكون من «أبو حسن»، فلا أظنني كنت لأتخلف عنها، حتى لو ذهبت متكئاً أو محمولاً في سيارة إسعاف. اقتربت من مجلس الفرح، ولاحظت اثنين يتهامسان بحذرٍ وقلق. أيقنت أن شيئاً ما قد وقع، ومع أنني لا أميل إلى السؤال أو التنقيب عمّا يتكتم الناس على أخباره، إلا أن رجفةً انتابتني؛ ذلك الإيحاء الذي يصدق دائماً في التعبير عن وقوع خطبٍ جلل. دخلت إلى الفرح، ولم أجد «أبو كريم»، الذي لا أعهده إلا أول الحاضرين، وكان ابن العم هشام واقفاً، فيما غاب سائر إخوته. قلت في نفسي: لعلني جئت مبكراً. خرجت متجهاً إلى حضور فرحٍ آخر، وكان الناس يسيرون زُرافاتٍ بين موقعي الفرحين. هناك بدأت الأخبار تتقاذف إلى مسمعي رغماً عني: أبو حسن في المستشفى، وحالته مجهولة. ثم ما لبثت الأخبار أن تواترت وتظافرت حتى تأكد النبأ، كان الناس يتناقلون الخبر ويتهامسون به، وقد امتزجت مشاعر الدهشة والألم على وجوههم؛ فقد كان بالأمس يدعوهم لمشاركته الفرح. غير أن تلك الدعوة بدت في تلك اللحظات وكأنها رسالة وداع أخيرة، وإنباءً بأنكم جميعاً محفوظون في القلب، محفوفون بالود.
لقد ذهب بسلامٍ وسكينة دون أن يسمح لأحد حتى بمجرد القلق عليه. لم يكن مريضاً، فيما أعلم، ولا متوعكاً من شيء. رحل في أبهى صورة، بعيداً عن ألم المرض وقسوته. رحل وترك لعائلته ومحبيه الألم والحزن والحسرة على فراقه. رحمك الله يا ابن العم بواسع رحمته، وعوّضك الجنة والنعيم الدائم، والعزاء كل العزاء لزوجتك وأولادك، ثم لإخوتك وأخواتك، وكافة العائلة الكريمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.