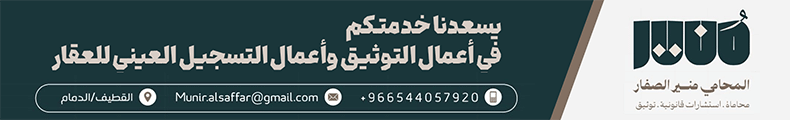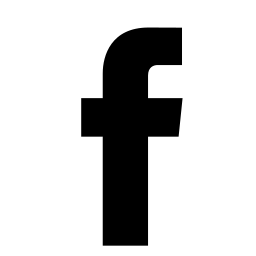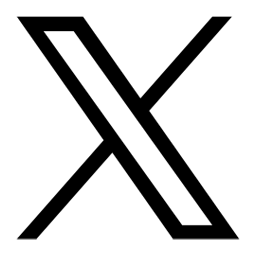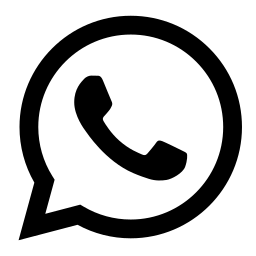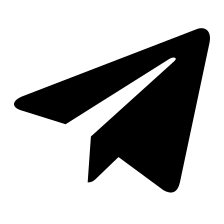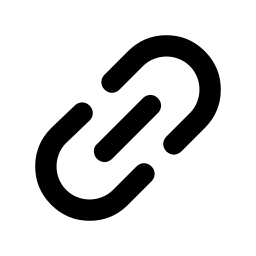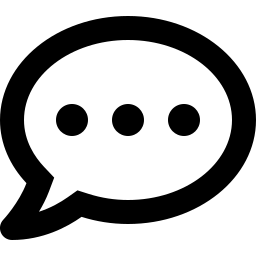وَجَادَلَ الإنسانُ ربَّه فكيف له أن يُنصف بشرًا مثله
يولد الإنسان وفي جعبته استعداد فطري للدفاع عن نفسه، وكأن الحروف خُلقت لتبرر أفعاله قبل أن تعبّر عنها. يخطئ، ثم يقيم محكمة في رأسه يدافع فيها عن المتهم الوحيد نفسه. وفي تلك المحاكم الصغيرة التي لا قاضٍ فيها ولا شهود، يخرج غالبًا مبرأً بوجه من الغرور، كأن التبرير بطولة وانحدار الوعي بطولة أخرى متخفية.
﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [القيامة: 14].
هذا الكائن العجيب يظن أن امتلاك لسان طويل هو امتلاك للحجة، وأن الصوت المرتفع علامة صدق. يخاصم الواقع ليعيد تشكيله على هواه، يجمّل قبحه بحروف مرتبة بعناية كأنه يبيع الوهم في غلاف من المنطق. يقنع نفسه أنه على صواب، ولو تكسرت به المرايا وسدت الطرق كلها في وجهه. قد يقنع الآخرين أن الخلل في الضوء وإعداداته لا في صورته، وفي الشوارع المتهالكة لا في طريقه.
﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ [غافر: 5].
هو لا يعتذر بسهولة، لأن الاعتذار يراه خسارة في سجل كبريائه، لا نبلًا في ميزان الوعي. فلو واجهته بحقيقته، لأخرج من جيبه قاموسًا من الأعذار لم يُكتب في قواميس الصدق والمقارنات والمجازات، ليُريك أن الآخرين أكثر سوءًا، وأنه بالمقارنة ضحية سوء الفهم، وبريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لا صانع الخطأ أو الجرم.
ومن طرافة المشهد أنه مهما تجملت حججه بأفعاله ونواياه، يدرك في أعماقه أن الحقيقة تراقبه بملامح ساكنة وربما بتأنيب ضمير. لكنه يكره النظر في عينيها لأنها تربكه وتهزه. فيختار المراوغة والهروب، يلونها بالضحكة والابتسامة، يغير الموضوع، أو يروي نكتة تسحب التوتر من تلك اللحظة. وهكذا ينجو مؤقتًا حتى تعود تلك الحقيقة لتقرع بابه من جديد حين يخلو إلى نفسه ويعود لها، فيزعم أن الوقت غير مناسب للتفكير، أو أنه يؤجل مواجهة ذاته إلى إشعار آخر.
﴿يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ [القيامة: 3].
﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: 24].
الإنسان قد يحاجج ربه يوم الحساب، لا يسلم إلا بعدما تغلق أفواههم وتتكلم جلودهم. فإذا كان في حضرة خالقه يبرر ويحاجج، فكيف به أمام الناس؟ أمام زوجة تعاتبه، أو صديق يذكره بوعد نسيه أو دين أو تصرف، أو مجتمع يعكس له عيوبه بوضوح لا يحتمله؟ هو لا يحب أن يكون مكشوفًا، فيحاول تغطية عوراته الفكرية وسوءه بعبارات محسنة وابتسامات ومراوغة تعرف كيف تغير مسار الحوار.
﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: 65].
الإنسان وإن جادل ألف مرة، يظل يحمل في داخله نقطة ضوء وبريقًا يتوقان إلى الاعتراف. تلك اللحظة التي ينظر فيها إلى خطئه بعين النضج والرجوع للحقيقة لا بعين خجلة. عندما يكتشف أن التبرير لا يصنع إنسانًا، إنما نسخة ضعيفة منه، وأن الاعتراف ولادة ثانية تخلصه من ثقل الزيف وتعيده إلى صدقه الأول.
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].
ومع ذلك، من النادر أن يصل الإنسان إلى تلك المرحلة. أغلبنا يعيش حياة مكوّمة كثيرة النقاشات التي لا تنتهي، والحوارات التي تبدأ بضحكة وتنتهي بخصومة وجفاء. نجيد تزيين أخطائنا أكثر مما نجيد إصلاحها، ونغضب إذا تجرأ أحد على فضح زلاتنا أو نصحنا بصدق وإخلاص نية. نرتب دفاعاتنا بسرعة تفوق بناءنا لأي صواب جديد.
﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54].
الإنسان صعب لا يتغير بسهولة، لأنه مخلوق متعطش لإقناع ذاته أنه أذكى مما هو عليه. ولو وُزعت بطاقات عضوية في نادي الذين لا يخطئون أبدًا لامتلأ قبل أن يُفتتح. ومع ذلك، تبقى الفرصة مفتوحة: متى ما تجرأ أحدنا على أن ينظر في نفسه ويراجعها بدل أن يدافع عنها، يبدأ التحول الحقيقي.
ذلك اليوم الذي يحتاج فيه إلى ضمير يسمع قبل أن يُسأل، لن يحتاج إلى فم يُختم ليعترف. عندها فقط يصبح الإنسان جديرًا باسمه لا بجداله.
﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8].