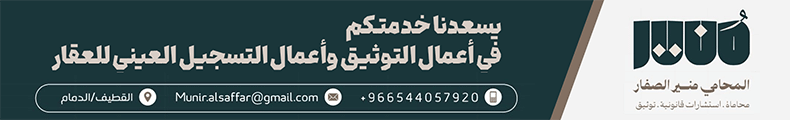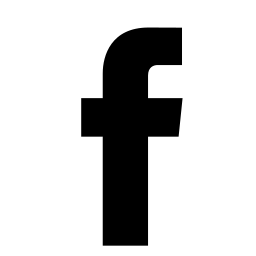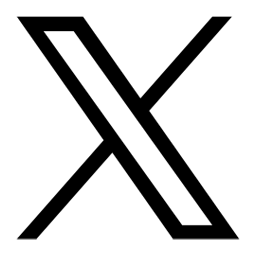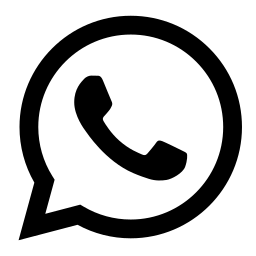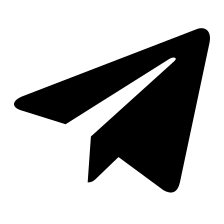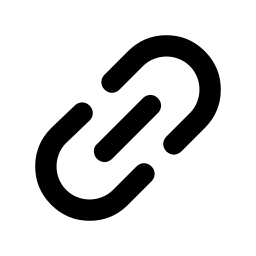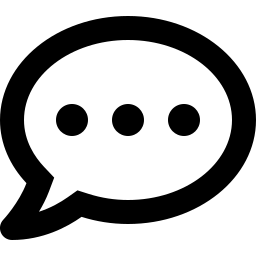فَأس أم بَأس؟
لا تغيب صورة الفأس «البَلطَة» النمطية عن ذاكرة الذهن المتيقظ، فهي الأداة المسعِفة والمنقِذة في تقليم وتقطيع أغصان الأشجار، ومِعول رئيس في كفاءة مِهنة الاحتطاب؛ وبدونها لا يقوى المُحتطِب المتكسب، حَولًا ولا قُوة، على القيام بمهام عمله، أو اكتساب واستدرار قوت رزقة. أما البأس، في الجانب المقابل الٱخر، فيعرف بسلامة القوة البدنية، ويوصف بمرونة النشاط والحيوية…
وهنا لا تكفي حِيازة وامتلاك كتلة الفأس النمطية وَحدها في جلب الرزق الحلال، واستهلال مهام الاحتطاب النشط؛ لإشعال نار مواقد الطبخ؛ وإنضاج اللحم؛ وإعداد فنون الطعام... وأحيانًا تُغري العامل العاجز، عن الاحتطاب، يد الفأس الملساء المتدلية من عُروتها المثبتة بجانب الحائط القريب، غير أن بَواعث النشاط المتدفق، وحَوافز الهمة الغامرة لا بد أن تبقى معطياتهما حاضرتين، وتنتصب ماثلتين قُبالة شغف عزيمة الاحتطاب الحافزة، جنبًا إلى جنب، مُتوشحة برشاقة الفأس الممشوقة؛ ومَحفوفة بأناقة طلعتها البهية؛ ورغم أن رسم صورة الفأس الأنيقة، وشكل سِيمائها المريح، الباعثا على حفز صلابة بأس العزيمة، في كسب الرزق، لا يُسعفا المتوعِك السقيم - المتزمل في أثناء دِثاره - بالنهوض المقتدر، وشحذ الإرادة السلسة، مادامت سواعد قواه خَائرة، ودعائم صِحته مُنتكسة!
ولعل قامة الفأس، وقوام الصحة توأمان مُتلازمان، لا ينفكان؛ لحفز واستحثاث الاستييقاظ والنهوض المبكر؛ لقدح وصقل همة وعزيمة المحتطب المتزامنتين، بمعية نظم نهضة سَيره المتئد قُدمًا؛ وتأبطه المرِح لنصل الفأس، بمتانة البأس، وأريحية المسعى؛ لبدء واستهلال مهام نشاط عمله اليومي المعتاد، وكما يُشاع في الأمثال الشعببة: «صنعة في اليد، أمان من الفقر».
هذا، ولن أكتفى هنا مرة باستعراض واستطراد العلاقة الكسبية المشتركة بين مهنة المحتطب الشاقة، وسلاح فأسه الحاد، بل سأشطح بَعيدًا، وبعدها أمرح حِينًا، في جُنينة الاستمتاع الٱمن بلقطة الفأس الفاخرة، والاستئناس المبهور برشاقة أيقونتها التقليدية المتعارفة؛ لاجتذاب واستقطاب لفيف منتخب من لقطات الصور الدلالية المتأمَلة، بمزيد من جُرعات كافية من وِقفات التدبر؛ وفيض وافر من نفحات التفكر، في قِمم صِهاء مسرح حياتنا اليومية… فعندما يتعكر صفو المزاج ساعة، لشخص أمامك، يعز عليك، تلحظ تسرب مشاعر حِدَّة مزاجه بفيض إفرازاتها الفسيولوجية المختنقة بسهولة المورد؛ وتُبصر تسلل مُهيجات غضبه المرتبكة بيسر الولوج، إلى جذور سُويداء صفو مزاجه الرائق، قبل ذلك؛ ولاحقًا تسهم، تلك المهيجات الطارئة بميسم تشويهاتها، في تقطِيب سائر قسمات وجهه النضرة، تباعًا…
حينئذٍ لا يلوي ذهن الشخص ”الهائج المائج“ نفسه، على أريحية حسن التواصل الفعال مع من حوله؛ ولا تُبصر حواسه المشتتة يد الفأس الملساء الرحيمة المندسة بوداعتها الساكنة في مستودع جوف غِمدها الٱمن، من جديد؛ لاسترعاء هنيهات الانتباه؛ واستدعاء لحظات التروي؛ واستنشاق شهقات كافية من جرعات ”الأوزون“ الشافية، في غُرَّة صباح يوم حالم؛ واستشراف مَوَاكب الرؤى الضافية، بصفاء أعماق الوجدان، من أعلى حَدَبَة رابية مُزهرة؛ خِلافًا لما يسلكه الشخص المنشرح المتفائل.
وهنا يتعذر، على نظيره الواجم المكتئب أخذ كبسولة مُهدئة؛ أو نيل قسط وافر من الاسترخاء المستجم، وسط زحمة الهَياج المُنفلت من قبضة سُكونه… عندها تنساب دوائر المَجَاس الحِسية القائدة إلى شغف سَبر أسرار النقاهة المزاجية الرائقة، بأبعادها الثلاثية المفقودة؛ وفي غيابها تعلو صيحات التذمر الهادرة؛ وتسيطر في فضاء محيطها المضطرب، استشاطات السخط الماطرة، إذ سرعان ما تتسرب أسواط المزاج السوداوية، وتُصقَل مَشارط التبرم الحادة، وتَتوارد سِهام الغضب المارقة..
هذا، وعند مَحط مَقام الفحص الواعي، ومَشفى دار مَهام التقييم المنصف، للحالة المزاجية الراهنة للشخص ”المصاب“، لا بد للمرافق اليقظ - بلطف عِشرته، وكرم مداراته - من مُعاينة ودراسة أعراض الحالة المسيطرة، برفق وألفة، عن كثب؛ لفهم خفايا أسرارها المتوارية المؤقتة؛ والوقوف المُتَبَيِّن على ٱثارها التشويهية الظاهرة؛ والتريث المتأنِ في إصدار حُكم مُتَيَقِن! والأمثل والأفصل، تأمل وتتبع أسبابها المثيرة المبيتة، وسبر أغوارها المحسوسة المتولدة من النواحي الفسيولوجية والنفسية والوجدانية.
وتوسعًا: لا بد من المساهمة الجادة الفاعلة في التخفيف الممكن من شدة وقع ٱلاَمها؛ والتقليل المُسعِف من وخز وهن مُعاناتها، على وِجدان المصاب؛ لتسمو بوادر الحكمة المستضافة، في محفل مَجلسها المترف؛ ويُصان مزاج الشخص المحرور، في أوج لحظات هياج حرارة الغضب؛ وتُلاطَف بحكمة قمم هُنيهات عصف الغيظ، قبل تفاقمها... عندئذٍ تنتَصر المُكاشفات الصريحة، بسماحة حِنكتها الرائدة؛ وتتصدر دوافع مُشافهات الوئام بأسمى مَعانيها القائدة؛ وتندى أيادي كبح تأجج واحتدام فورة الهياج المتظاهرة؛ وتنحسر هَبات النفور البغيضة؛ وتروق غَلبة وتعاظم كدر المزاج المتعكرة...
وبانتصار جذب وشد، دفتي هذا المنحى السديد الرشيد؛ وعلى مَنابر مُنتدى النهج القويم تصفو النفوس؛ وتطيب الخواطر؛ ويعود نبض الدم المتجدد في دورة الشرايين المتوترة إلى سابق عهده؛ ويؤوب وهن الاعتلال الفسيولوجي الظاهر إلى صفاء طبيعته…
وهنا يشرق سِر الوفاء المتبادل مُستبشرًا؛ ويسطع زَهو رشاقة المزاج المتعادل مُتبخترًا، مُكللَين معًا، بدفء بُردة الحِلم الزاهية، ومحروسَين سويًا، بشمول رداء المحبة الودود. وفي جانب الضفة الأخرى بمخدع خَلوة فيض التداول ”البينشخصي“ الحميم، ومُلتقى غَمرة هَوادة التواصل السمح، تفوز، بامتياز مَلحوظ؛ وتندى باستحسان مَغبوط، بإذن الله، جزالة سداد الرأي؛ وتُهدى صِلاتها المُجزية طواعية بعصا السبق الظافر…
وفي أركان رواق ذلك الموقف الحساس المتأزم؛ فليشمر الرحَماء المشفقون عن مُتون سَواعِدهم الرؤوفة، بإهداء فيض غامر من حُسن المداراة السديدة؛ وإمداد انعاش مساند صادق للموقف المتوتر ذاته، قلبًا وقالبًا؛ ورفع رايتهم البيضاء بأريحية عَطوف، ويدٍ طولى، بمواساة صفية صادقة؛ واقتراب رحيم حميم؛ لمسح وكبح ٱثار سوء الاعتلال المزاجي المسيطر، في حينه، أوبعد حين.
وفي متسع سُوح مواكب ذلك المُبتغى المحمود، ومسارح فضاءات تقدمه المحبور، فليتنافس المتنافسون، ويسعى الساعون إلى تحميد منابع سماحة الوئام، وتمجيد هِبات نُبل الفضيلة!