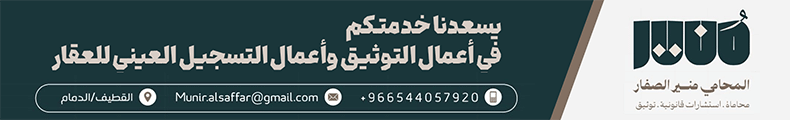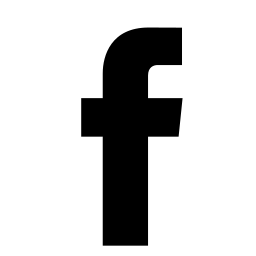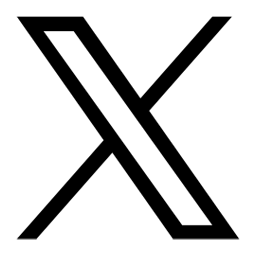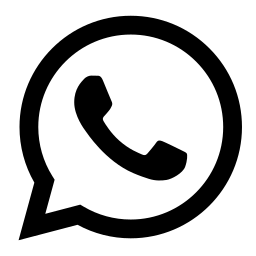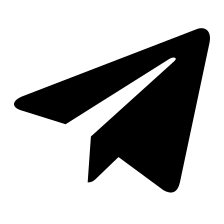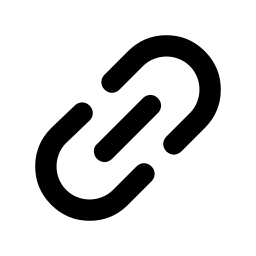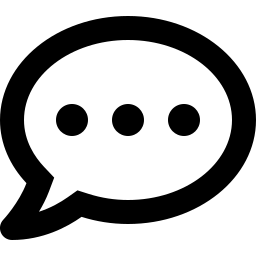أكثرهم لا يعقلون
مصطلح العقل الجمعي يطلق ويراد منه الحالة التي تسيطر على الفرد أثناء تواجده وسط جماعة لها نمط معين وتصرفات معينه وسلوكيات خاصة فيتأثر بتلك الصرفات ويسلك مسلكها ويتصرف تصرفاتها على النحو الذي ربما قد لا يكون متسقا مع شخصيته ولا يكون معتادا على سلكه، فيبدأ بممارسة سلوكيات وتصرفات معينة دون تفكير سوى أن تلك المجموعة تقوم بها فيحذوا حذوها دون إدراك ولو كان بمفرده لم يقم بها، فبملاحظة بعض الشواهد من حولك وبالنظر لكثير من التجارب التي أجريت على سلوك الفرد حين يحاط بمجموعة تقوم بعمل معين بطريقة خاصة فإنك ستذهل من سرعة استجابة الفرد لسلوك الجماعة فيقوم بالعمل بالطريقة ذاتها التي يرى فيها تلك الجماعة تقوم بها دون تفكير أو الرجوع لعقله وما اعتاد عليه.
ومن الناحية الاجتماعية لربما هذه التصرفات قد تكون ضرورية إلى الحد الذي يجعل منها مؤشرا للذكاء الاجتماعي، فعلى سبيل المثال اختلاط شخص ما مع مجتمع غير مجتمعه يختلف عنه في عاداته وتقاليده وسلوكياته يتطلب منه أن يسلك سلك ذلك المجتمع في عاداته وتقاليده دون المساس بالقيم والمبادئ التي يعتنقها الشخص، هذا الانخراط يجعل من الشخص مرغوبا فيه ومحترما في مجتمع حكمت عليه الظروف مجانسته.
ولكن وبطبيعة الحال فليس كل اندماج في سلوك جماعي هو أمر إيجابي، فلا بد من إعمال العقل تجاه كثير من السلوكيات الاجتماعية، فالمنهجية الحقة لا تعرف بالكثرة والقلة وهذا مبدأ حثت عليه التعاليم السماوية إذ دعت لإعمال العقل بدلا من الاعتماد على الإرث الاجتماعي والعادات والتقاليد في تحديد ما يجب على الفرد أن يؤمن به وفي هذا السياق نتأمل بعض الآيات الشريفة فيقول الباري عز وجل «وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون»، «وإن كثيرا من الناس لفاسقون»، «وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم»، «وأكثرهم لا يعقلون»، «ولكن أكثرهم يجهلون»، «وإن كثيرا منهم لا يفقهون»، «بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون»، «أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون»، «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» وهذه دلالات واضحة لإعمال العقل تجاه الموروثات الاجتماعية إذ ليس بالضرورة أن يكون الموروث سليما لاتباعه أتباعا أعمى، فلابد من تحريك العقل باتجاه الثوابت الدينية والعقلية وعدم الانسياق وراء العددية والأكثرية.
أما من الزواية الأخرى وكيف هي العُلقة فيما يخص حالة المجتمع ممثلا بعقله الجمعي والأفراد الذين لا ينتهجون نفس المنهج الاجتماعي ولا ينخرطون في مذهب الجماعة ولا يسلكون سلكها فهي علاقة متوترة دوما بلا شك خصوصا إذا ما كان المجتمع ينتهج منهجا لا يوافق الفطرة والتعاليم وكان مجتمعا ممثلا بعقله الجمعي يعارض مبادئ الفرد، فبالنظر لأشهر الأحداث في تاريخ البشرية كخير مثال وهي حياة الأنبياء والمرسلين سنجد شواهد كثيرة وجلية توضح هذا الأمر، فحين اصطدمت مصالح المشركين وعاداتهم الإجتماعية مع رسالة نبي الأمة احتشدت ضده أطياف المجتمع نصرة لمصالحهم وموروثاتهم وترجمة لهيمنة العقل الجمعي، فلم يكونوا على استعداد لسماع صوت العقل والحجة والبرهان وهم على ماهم عليه من موروث اجتماعي وجدوا عليه آباءهم، فكالوا التهم نحو شخص النبي الأعظم واتهموه بالجنون انتصارا للعقل الجمعي الذي اعتادوا العيش به.
كذلك فعل قوم لوط تجاه نبي الله لوط حين عكف على محاربة الفساد والرذيلة فقالوا بصوت العقل الجمعي «اخرجوا آل لوط من قريتكم فإنهم أناس يتطهرون» هكذا انتصر قوم لوط لرغبة جماعية كانت تحرك عقولهم وغرائزهم نحو سلوك معين، لذا نجد في حياة المصلحين الكثير من العقبات الاجتماعية التي واجهتهم واصطدمت بمقاومة العقل الجمعي لأي تغيير للمورثات والعقائد التي تدين بها تلك المجتمعات، إذ أن تغيير نمط تفكير جماعة تتوحد بعقلية معينة أمر بالغ الصعوبة.
من ناحية أخرى فإن وجود حالة كهذه تؤثر على الفرد حين يوجد في مجموعة تمارس أسلوب واحد ونمط واحد في طريقة إدارة بعض الأمور لربما تستغل جيدا في مواطن كثيرة، على سبيل المثال فالمعلم يضبط طلابه على نسق واحد من خلالها، فيبدأ ببرمجة عقول الطلاب بالكيفية التي تساعده وتساعدهم على عملية التحصيل العلمي والدراسي، إلا أن هذه الطريقة ليست ناجعة في كل الأحوال فلابد من إعطاء مساحة للفروق الفردية بين الطلاب والظروف الشخصية أيضا، كذلك يستغل مدراء وأرباب العمل هذه الحالة في تسيير أعمالهم وموظفيهم من خلال نشر ثقافة سلوك القطيع وبرمجة العمل على وتيرة معينة لذا فإن بعض المدراء والقادة يصطدمون بأي انحراف عن العقل الجمعي الذي زرعه في إدارته والذي قد يصدر من موظف لا ينسجم مع تلك الحالة وينجز ما يناط به بطريقة أخرى، ولربما تكون أقل جهدا وأكثر نفعا، إلا أن خروجه عن القطيع ربما يثير حنق مسؤوله حينها الذي لا يجيد كيف يتعامل مع اختلاف العقليات والفوارق الفردية والثقافية بين موظفيه.
وفي الحياة المعاصرة نجد أن كثيرا من المجتمعات وخصوصا المنغلقة لا يمكن لها أن تتقبل وجود أفراد مختلفين في جانب أو جوانب عدة عنها، فغالبا ما يحدث التصادم بين تلك المجموعات والأفراد أو الأقليات، فمسألة تفهم الشخص لعادات المجتمعات الأخرى مسألة مهمة لانخراط الشخص تحت مظلة مجتمعات جديدة أو طارئة أو مؤقتة ومسألة قبول الاختلاف مسألة مهمة لتطور المجتمعات نحو الأفضل والرقي بها وعدم الانكفاء على حيطانها خصوصا في عالم يتسارع ويتقارب في كل يوم حتى تلاشت كثير من الاختلافات والفروقات بين المجتمعات وأخذت في التشابه في ظل الطفرة العلمية في مجالات التكنولوجيا والتواصل وتطور القوانين العقلية والمدنية.