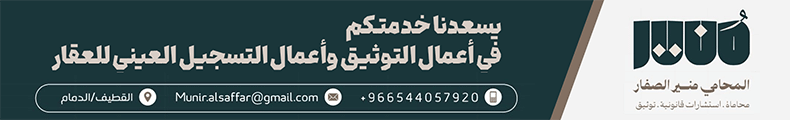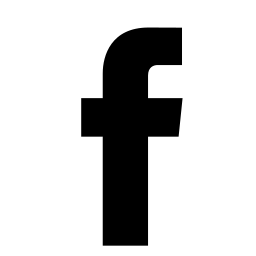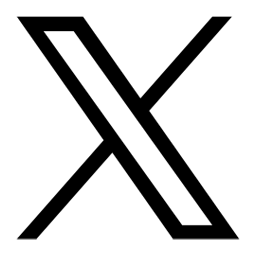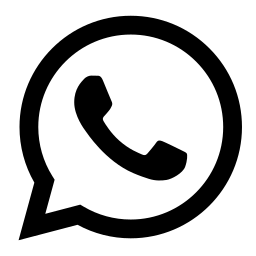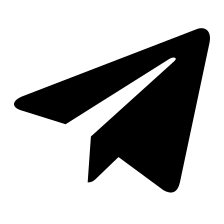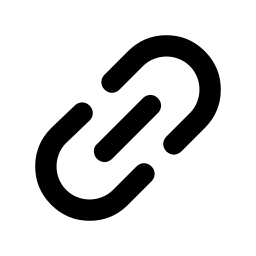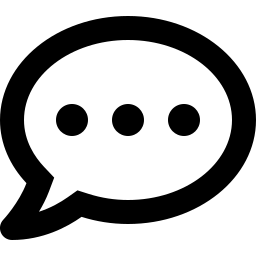مستقبل الثقافة في السعودية
يعد كتاب الدكتور طه حسين «1306 - 1393 هـ / 1889 - 1973م» «مستقبل الثقافة في مصر» الصادر سنة 1938م، أول كتاب في الأدب العربي الحديث يتحدث بشكل مستفيض عن مستقبل الثقافة، ويقرن ما بين الثقافة والمستقبل، ويضع الثقافة في صلب الحديث عن المستقبل، ويلفت الانتباه إلى أثر الثقافة في مستقبليات الدول والمجتمعات، وأن لا مستقبل ولا مستقبليات من دون الثقافة، مؤكدًا منظورًا حيويًّا يمكن تسميته المنظور الثقافي المستقبلي. كان المفترض من هذا الكتاب أن يأخذ في وقته صفة البيان الثقافي، ويكون دافعًا لتكوين وعي جديد في البلاد العربية نحو الالتفات لمسألة العلاقة بين الثقافة والمستقبل، وعيًا يجعل الحديث عن مستقبل الثقافة يجوب هذه البلاد وينتعش فيها، متجلّيًا في الحديث تارة عن مستقبل الثقافة في العراق، وتارة في الحديث عن مستقبل الثقافة في المغرب، وتارة في الحديث عن مستقبل الثقافة في السودان، وهكذا في باقي الدول والمجتمعات العربية الأخرى، لكن هذا لم يحدث!
لم يحدث هذا الأمر أو هذا التطور الثقافي المفترض، نتيجة ما حصل لكتاب طه حسين من التباسات واعتراضات حادة أدت إلى تعثر مهمته أو فشلها في موطنه، فحجبت إشعاعه عن أن يمتد ويصل إلى الدول والمجتمعات العربية الأخرى. الفشل الذي شعر به طه حسين متأسفًا، حين رأى بنفسه طريقة الاستجابة الملتبسة لرؤيته أو خطته في النهوض الثقافي لبلده، فقرر إيقاف طباعة الكتاب مرة أخرى، راغبًا في مراجعته وإعادة النظر فيه، فعد من مؤلفاته التي لم تطبع مرة ثانية في حياته، وبقي الكتاب على حاله من دون مراجعة ولا تغيير.
ومن بعد هذا الكتاب لم تظهر تجربة مماثلة في مكان آخر، تتخطى محاولة الدكتور طه حسين أو تتواصل معها، وتجدد الحديث بسياقات ونظرات مختلفة حول مستقبل الثقافة في المجال العربي العام أو المجال الوطني الخاص.
وكنا بحاجة ماسة لمثل هذه المحاولات على الصعيدين العربي والوطني، وبخاصة بعدما انبثقت عندنا التجربة الأولى، وكان من الممكن أن يتبلور معها مسار يكون منتظمًا من جهة، وممتدًّا من جهة أخرى، مسار يتصل بالحديث عن مستقبل الثقافة في الأوطان العربية كافة، وهذا ما لم يحدث لأننا لم نعطِ محاولة طه حسين صفةَ انبثاق التجربة الأولى، ولم نتعامل معها كونها مثلت مسارًا كان علينا الانخراط فيه والانتظام.
وإذا اعتبرنا أن هذه المحاولة قد تعثرت أو فشلت في عصرها وفي موطنها، فهذا لا يعني على الإطلاق الانقطاع عنها ومحوها ونسيانها، وعدم الاستلهام منها، حتى مع الاختلاف معها من جهة النظرات والتحليلات والمرجعيات جزئيًّا أو كليًّا، وذلك لكونها المحاولة التي لم تنسخها محاولة أخرى لا في موطنها مصر، ولا في باقي البلاد العربية الأخرى. لهذا ستظل هذه المحاولة حاضرة في دائرة الاهتمام والإلهام، لا أقل في أفقها العام الذي يتصل بتأكيد العلاقة بين الثقافة والمستقبل.
وفي نطاق هذا الاستلهام نتساءل في مجالنا الوطني: ماذا عن مستقبل الثقافة في السعودية؟ ومتى نكتب عملًا يستشرف لنا هذا الأفق؟ عملًا نريد منه أن يحمل صفة الكتاب المرجعي، أو صفة الكتاب الرائد، أو صفة الكتاب الملهم، أو غير ذلك من الصفات العالية والمميزة، بحيث يرسم لنا خطة، ويكتشف لنا أفقًا، ويفتح نقاشًا يكون واسعًا وممتدًّا حول مستقبل الثقافة في السعودية، وما يتفرغ منه في الحديث عن مستقبلنا الثقافي ومنظورنا الثقافي المستقبلي. يتأكد هذا الأمر من ناحية الزمن، مع وجود أول وزارة في تاريخ السعودية تعنى بالثقافة متفردة بهذا الشأن، ومع وجود هيئة عامة للثقافة، وفي ظل مشروع الرؤية السعودية التي تتخذ من المستقبل الطموح وجهة لها.
إسهامًا في بلورة الرؤى والتصورات، وتفاعلًا مع النقاشات السائدة حول هذا الشأن الثقافي، أتقدم بهذه الملاحظات الآتية:
أولًا: في البحث عن صورتنا الثقافية
عندما نريد أن نبحث عن صورتنا السياسية نحن كدولة ومجتمع، الصورة التي تميزنا بقدر ما عن باقي الدول والأمم الأخرى، أو تعرفنا عند هذه الدول والأمم، أو التي تعطينا قدرًا من الفرادة أو الاختلاف عن غيرنا، فإن من السهولة التعرف على هذه الصورة في المجال السياسي، حيث تكشف عنها مجموع السياسات القائمة والمتراكمة منذ ما يزيد على سبعة عقود، كما تكشف عنها كذلك، مجموع المواقف السياسية المتحركة والمتفاعلة مع الأحداث الجارية، وطبيعة العلاقات السياسية مع الدول والمؤسسات.
وعندما نتحدث عن صورتنا الاقتصادية، فإن من السهولة كذلك، اكتشاف هذه الصورة، والتعرف عليها، وعلى ملامحها ومعالمها ومكوناتها؛ لكونها صورة ظاهرة ومتجلية لنا، وإلى العالم الذي نتفاعل معه ويتفاعل معنا.
ويكشف عن هذه الصورة مجموع النشاطات والخطط والعلاقات والإستراتيجيات ذات الطابع الاقتصادي، فالجميع يعلم أننا دولة نفطية مؤثرة في اقتصاديات العالم، ولدينا مخزون نفطي كبير، الوضع الذي فرض على الجميع في أن يتعرفوا على صورتنا الاقتصادية.
وهكذا عندما نتحدث عن صورتنا الدينية، فإن هذه الصورة تكشف عن نفسها من خلال مجموع النشاطات والمؤسسات والعلاقات ذات الطابع الديني، وبحكم التفاعل والتواصل النشط والواسع مع العالم الإسلامي، ومع جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، الذين يأتون سنويًّا إلى الحج من كل فج عميق.
لكن عندما نتحدث عن صورتنا الثقافية، ونحاول أن نتعرف على هذه الصورة في أبعادها وملامحها، حدها ورسمها، فإن الوضع في هذه الحالة سوف يختلف. لا أعلم حقيقة طبيعة رؤية الآخرين لهذه الصورة وكيف يفهمونها؟ وأين يتفقون فيها؟ وأين يختلفون؟ وما درجة الوضوح عندهم في تشخيص هذه الصورة وتحديدها؟ وما درجة الغموض عندهم أيضا؟ لكن الذي أراه من دون أن أكون قاطعًا، ولست راغبًا في القطع أو الجزم، أن هذه الصورة ليست بذلك الوضوح، وأظن أنها ليست واضحة عند الكثيرين كذلك، أو لا أقل أحتمل أن هناك من يشاطرني ويوافقني على مثل هذا الرأي. أقول هذا الكلام والثقافة هي أقرب المجالات إلى نفسي، وهي الحقل الذي أوليه كل اهتمامي، مع ذلك عندما أحاول البحث عن صورتنا الثقافية أجد صعوبة في تحديد وتشخيص هذه الصورة.
يجب أن نعلم ابتداء أن الثقافة هي المجال الذي لا ينبغي التستر عليه، أو كتمان الحق فيه، فالثقافة من طبيعتها الشفافية، وهكذا ينبغي أن ننظر إليها، فما الذي جعل هذه الصورة الثقافية ليست بذلك الوضوح، أو الاكتمال؟ هل لأن الثقافة كانت إلى عهد قريب لا يجمعها جامع، ولا يربطها رابط، باعتبار أنها كانت موزعة ومتفرقة بين الأجهزة والمؤسسات والوزارات، قبل أن تجتمع عند جهة محددة هي وزارة الثقافة؟ أم لأن مجموع النشاطات ذات الطابع الثقافي لم يكن بالقدر الكافي الذي يكون بإمكانه بلورة صورة ثقافية ناضجة ومحددة الملامح؟ أم أن هذه النشاطات أقل بكثير مقارنة بمجموع النشاطات المرتبطة بالمجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والدينية؟ أم لأنه لم تكن لنا سياسة وإستراتيجية واضحة ومحددة في مجال الثقافة، على صورة الإستراتيجية التي أقرها مؤتمر المثقفين السعوديين الأول؟ أم لأن الصورة الدينية غطت على الصورة الثقافية، أو أننا اكتفينا بالصورة الدينية، أو أننا لم نرد مزاحمة الثقافة للصورة الدينية؟ سواء اتفقنا أو اختلفنا على هذه التصورات والتحليلات، مع ذلك يبقى أننا بحاجة لأن نسهم في بلورة وصياغة صورتنا الثقافية، الصورة التي يرى الجميع نفسه فيها، وبكل ألوان الطيف لتكتسب جمالية ألوان الطيف، وأن تكون معبرة عن جميع مكونات النسيج المجتمعي السعودي، وعندئذ ستكون هذه هي صورتنا الثقافية، وهذا هو مصدر الثراء والتخلق في كل صورة ثقافية! ويبقى السؤال مفتوحًا في البحث عن صورتنا الثقافية، فما هذه الصورة؟
ثانيًا: ما سؤالنا الثقافي؟
لعل أهم سؤال يمكن أن نطرحه على أنفسنا في مجالنا الثقافي هو: ما سؤالنا الثقافي؟ لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال بحاجة إلى عصف ذهني، ومزيد من إعمال الفكر، وتكثيف التأمل والنظر، فهو السؤال الذي يبلور وجهة الثقافة، ويصيغ روحها العامة، ويحدد لنا ماذا نريد منها، وكيف ترتبط الثقافة بحاجاتنا الملحّة الراهنة والمستقبلية، وهي الحاجات التي يفترض أن تنتهي في حركتها إلى ما يخدم ويعزز التقدم العام والتطور الشامل. كما أن هذا السؤال، هو بمثابة اكتشاف بوصلة الثقافة، وهل يمكن للثقافة أن تكون بلا بوصلة ترسم لها الطريق، وتبلور لها المسارات والاتجاهات.
والثقافة بلا سؤال ثقافي، هي ثقافة بلا وعي وبلا بصيرة بذاتها ووجودها، بحركتها وفاعليتها، بحاضرها ومستقبلها. وفي مثل هذه الحالة تصبح الثقافة مشتتة، ومعرضة للتفتت والانقسام، وقد تتنازعها الرغبات والأهواء من كل جانب.
وهذا يعني أن البحث عن سؤالنا الثقافي، هو بحث عن جوهر الثقافة وعمقها، وهو من جهة أخرى بحث عن الجانب الوظيفي في الثقافة، بمعنى أنه السؤال الذي يحدد للثقافة وظيفتها، ولكن ليس أي وظيفة، وإنما الوظيفة الواعية والكبيرة التي تتصل بالمتطلبات الفعلية في نطاق علاقة الثقافة بالمجتمع.
والسؤال اللافت والمحير هو: كيف يغيب عنا مثل هذا السؤال؟ أو لا يتجدد طرحه باستمرار؟ مع أنه السؤال الذي يفترض ألّا يغيب عنا؛ لأن الإجابة عليه أو الاقتراب من هذه الإجابة، ليس فقط لا تتوقف على مجرد إبداع هذا السؤال واكتشافه، وإنما على طرحه المتكرر، وكثرة النظر فيه؛ لأنه ليس من نمط الأسئلة البسيطة أو السهلة أو العادية، بل هو سؤال الأسئلة في الثقافة، وسؤالها الحيوي، ويفترض أن يمثل محور النقاشات فيها.
متى ما غاب هذا السؤال، غابت معه تجليات الثقافة، وتجليات الفعل والحضور، وكيف للثقافة أن تتطور من دون سؤال ثقافي يحدد لها عنصر الفعل والحركة، ويحدد لها أيضًا، عنصر الدور والوظيفة، ويربطها بقضية تتصل بها وتتفاعل معها. يضاف إلى ذلك أن السؤال الثقافي، هو الذي يشكل طبيعة العلاقة بين الثقافة والمجتمع، فكل مجتمع يفرض سؤاله الثقافي بحسب طبيعة مكوناته، وكيف ينظر هو إلى ذاته، وكيف يفكر في مستقبله، وحاجته للتطور والتقدم.
من هنا يختلف السؤال الثقافي من مجتمع إلى آخر، فالسؤال الثقافي في مصر مثلًا، يختلف بطبيعة الحال عن السؤال الثقافي في لبنان، وكذا عن السؤال الثقافي في السودان، وهكذا الحال عن السؤال الثقافي في مجتمعنا.
كما أن هذا السؤال الثقافي، يتغير ويتجدد في داخل المجتمع الواحد بحسب المراحل والأطوار التاريخية والفكرية التي يمر بها كل مجتمع. لكن هذا التغير والتجدد في السؤال الثقافي لا يكون سريعًا أو فوريًّا، ولا يكون عفويًّا أو طارئًا، وإنما يحصل بقصد ووعي، ويحدث نتيجة محصلة تراكم الوعي، وتطور التجربة والخبرة الفكرية والتاريخية. فما سؤالنا الثقافي في حاضرنا الراهن؟
ثالثًا: ماذا عن واقع البحث الأدبي والفكري؟
يصلح هذا السؤال أن يكون مدخلًا لتكوين نظرة نقدية وتقويمية لعموم البحث الأدبي والفكري عندنا، ومعرفة طبيعة حركته ومسلكياته، والكشف فيما إذا كان هذا الحقل، مواكبًا لمثيله في العالم العربي؟ أم متأخرًا عنه؟ أم متقدمًا عليه؟ وما هي العلل والأسباب في جميع هذه الحالات؟
وإذا أردنا أن نقرر رؤية محددة، يمكن القول: إن هناك تقدمًا في البحث الأدبي والفكري على مستوى الأشخاص، وتأخرًا على مستوى المؤسسات، فليست عندنا جامعة بنشاط جامعة محمد الخامس في المغرب الفاعلة بقوة في إنماء وتطوير ونهضة الحياة الأدبية والفكرية والفلسفية هناك، وليس عندنا مؤسسة بنشاط المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وليس عندنا برنامج كبرنامج «القراءة للجميع» و«مكتبة الأسرة» في مصر، أو مشروع كالمشروع القومي للترجمة في مصر. هذه بعض اللمحات التي أردت منها أن تفتح نقاشات لا أن تقدم إجابات حول مستقبل الثقافة في مجالنا السعودي.