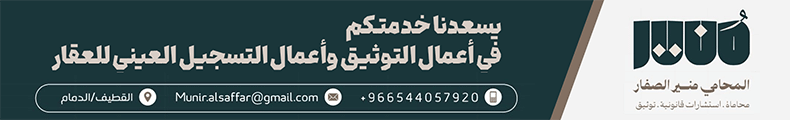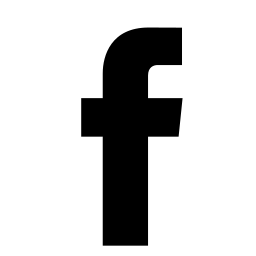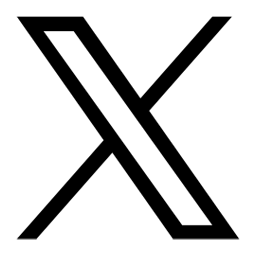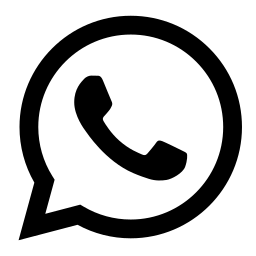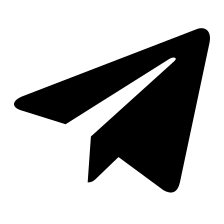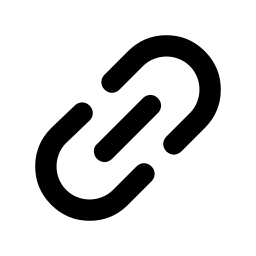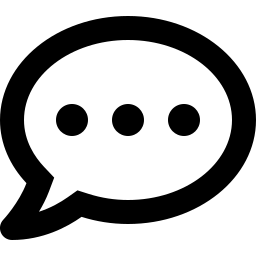على عتبة رمضان: دعاء الدخول إلى ضيافة الله
يمثّل الدعاء المروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق في آخر ليلة من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان - كما أورده الشيخ عباس القمي في كتاب مفاتيح الجنان - نصًا تربويًا وروحيًا بالغ العمق، لا يقتصر على كونه ألفاظًا تُتلى، بل هو برنامج عبادي متكامل يعيد ترتيب علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبالزمن الذي يدخل فيه.
هذا الدعاء يقف على عتبة التحول؛ بين شهر مضى وشهر أقبل، بين زمن الإعداد وزمن الضيافة، بين الرجاء والخوف، وبين الشعور بالتقصير والطموح إلى القبول. ولذلك فإن قراءته قراءةً واعية تكشف أنه ليس دعاء لحظة، بل منهج حياة لشهر كامل.
يفتتح الإمام الدعاء بقوله:
«إن هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن… قد حضر».
إنه إعلان حضور، حضور زمن استثنائي ارتبط بالوحي والهداية والفرقان. هنا يتعلم المؤمن أن رمضان ليس مجرد تقويم، بل فرصة إلهية لإعادة التشكيل الداخلي. لذلك يأتي الطلب الأول:
«فَسَلِّمْنا فيه، وسلّمه لنا، وتسلّمه منا في يسر منك وعافية».
السلامة هنا ثلاثية: سلامة الدخول في الشهر، وسلامة العمل أثناءه، وسلامة القبول بعده؛ كأن الإمام يلفت إلى أن أعظم الخسارة ليست التعب، بل أن يمرّ الشهر دون أثر.
حين نقرأ: «فَسَلِّمْنا فيه، وسلّمه لنا، وتسلّمه منا في يسر منك وعافية» نشعر أننا أمام خريطة نجاة كاملة، لا مجرد أمنية عابرة. الدعاء لا يتحدث عن الصوم فقط، بل عن رحلة كاملة تبدأ قبل رمضان، وتمتد خلاله، ولا تنتهي إلا بعد أن يُرفع العمل.
«فَسَلِّمْنا فيه» أي بلّغنا الشهر ونحن في عافية دينًا وبدنًا وقلبًا. كم من إنسان كان ينتظر رمضان، فلم يدركه، أو أدركه مثقلًا بما يمنعه من اغتنامه. الوصول إلى الموسم نعمة، والتهيؤ له نعمة أخرى، فكم من حاضرٍ غائب، وكم من صائمٍ لا يعيش المعنى.
ثم يقول: «وسلّمه لنا»؛ وهنا يتحول الدعاء إلى طلب الحفظ أثناء المسير. أن يبقى الشهر نقيًا من المكدّرات، محفوظًا من الغفلة، بعيدًا عن الضياع في التفاصيل. أن لا تسرقه العادات، ولا تفرغه الانشغالات، ولا يتحول إلى أيام تمضي بلا روح. أن يُسلَّم إلينا رمضان صحيح المعنى، كامل الفرص.
أما «وتسلّمه منا» فهذه أعمق المراحل وأشدها رهبة. فالعبد يخشى أن يعمل ثم لا يُقبل عمله. يخاف أن يتعب، ثم يُطوى الشهر ولا يبقى في صحيفته أثر. لذلك يطلب من الله أن يتسلّم هذا الجهد القليل، أن يرفعه برحمته، وأن يكسوه القبول.
ويزيد الدعاء: «في يسر منك وعافية»، أي بلا مشقة تُقعد، ولا بلاء يُفسد، ولا تعبٍ يقطع الطريق. يريدها رحلة رحيمة، تقوده إلى الله برفق، لأن القلوب إذا أرهقها العناء ربما ضعفت عن الاستمرار.
في هذا الدعاء تربية دقيقة: ليست القضية أن تصوم، بل أن تصل، وأن تثبت، وأن يُقبل منك. الخسارة الحقيقية ليست في الجوع والعطش، بل في أن ينتهي الموسم كما بدأ، بلا تغيير في القلب، ولا أثر في السلوك.
إنها مناجاة من يعرف أن النجاة ليست في كثرة العمل، بل في أن يُحاط العمل بعناية الله من أوله إلى آخره. فمن سُلِّم في رمضان، وسُلِّم له رمضان، وتسلّمه الله منه، فقد ربح الرحلة كلها
حين يقول العبد: «يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل مني اليسير» فهو يدخل من أوسع أبواب الرجاء، باب معرفة الله لا معرفة نفسه. هو يعرف محدوديته، لكنّه يعرف قبل ذلك سعة فضل ربّه.
الإنسان بطبيعته قليل العمل، سريع الفتور، تحاصره الغفلة وتسرقه الأيام. ولو حُوسب بعدلٍ محض لتوقف من البداية. لكن الذي يمنحه الجرأة على التقدّم هو أن الله يعامل بالفضل لا بالحساب الرياضي.
الحسنة عنده تتضاعف، والنية تُكتب، والخطوة تُبارك، واليسير يكبر حتى يغدو جبالًا من الأجر. لذلك يطلب القبول لا لِعِظَم ما قدّم، بل لعِظَم من يتقبّل.
في هذه العبارة يتحرر القلب من شلل الإحباط؛ فالمطلوب ليس الكمال، بل الصدق. وليس العبرة بكم تفعل، بل لمن تفعل.
وحين يؤمن العبد أن القليل ينمو عند الكريم، يبدأ بالعمل بدل التردد، ويبادر بدل التأجيل.
إنها دعوة خفية ألا تحتقر أي طاعة؛ ركعة، دمعة، صدقة، كلمة طيبة… فرب يسير فتح أبوابًا عظيمة.
بهذا الفهم يتحول اليسير إلى مشروع أمل، ويتحوّل العجز إلى حركة.
فالذي يُنمّي البذور الصغيرة قادر أن يجعل من نياتنا المحدودة عطاءً لا ينتهي.
حين يقول الداعي: «أن تجعل لي إلى كل خير سبيلًا، ومن كل ما لا تحب مانعًا» فهو لا يسأل الثمرة فقط، بل يسأل الطريق إليها. يدرك أن الخير ليس فكرة عامة، بل أبواب محددة، ومداخل دقيقة، وأن الإنسان قد يشتاق إلى الصلاح لكنه يضل المسار.
كم من شخص يحب الطاعة، لكن الفرص لا تتهيأ له، أو تعترضه نفسه، أو تجرّه الظروف إلى غير ما يريد. لذلك يصبح التوفيق أعظم من الإرادة؛ فليست المشكلة أن تعرف الخير، بل أن تُقاد إليه.
الدعاء هنا يربي في القلب حقيقة عميقة: أن الهداية حركة مستمرة، وليست لحظة عابرة. في كل يوم تحتاج أن يُفتح لك باب، وأن يُغلق عنك باب آخر.
وهو اعتراف بأن البصيرة محدودة؛ فقد يرى الإنسان في شيء نفعًا وهو باب هلاك، وقد يكره أمرًا وفيه نجاته. لذلك يسلّم القيادة لمن يعلم.
أما طلب المانع من كل ما لا يحب الله، فهو رحمة خفية. أحيانًا النجاة ليست في أن تسير، بل في أن تُمنع.
كم من عثرة حمت، وكم من حرمان أنقذ، وكم من باب مغلق كان عين العناية.
بهذا الدعاء يتعلم الإنسان أن أعظم النعم ليست الوصول، بل الإرشاد، وليست القدرة، بل التسديد.
إنه دعاء من يعرف أن الطريق إلى الله لا يُمشى بالأقدام فقط، بل يُفتح بالرحمة.
يتكرر في الدعاء: «عفوك عفوك عفوك»، وكأن الكلمة ليست طلبًا عابرًا بل نَفَسًا يتردد في الصدر. التكرار هنا ليس زيادة لفظ، بل زيادة افتقار؛ فالقلب كلما أعاد السؤال شعر أكثر بحاجته، وكلما شعر بالحاجة اقترب من باب الرجاء.
العبد حين يكرر العفو لا ينظر فقط إلى معصية فعلها، بل إلى نعمٍ لا يستطيع أن يحيط بشكرها. يدرك أن التقصير أوسع من الذنب، وأن الغفلة قد تكون في مواضع لم ينتبه لها أصلًا.
هو يطلب العفو عن خطأ يعرفه، وخطأ لا يعرفه، وعن واجب قصّر فيه، وعن حقٍ لله لم يؤده كما ينبغي. لذلك لا تكفي مرة واحدة، لأن الشعور بالنقص متجدد.
ثم إن التكرار يربي في النفس التواضع؛ فلا يرى الإنسان عبادته منقذة له، بل يرى نجاته في رحمة الله. مهما صلى وصام وعمل، يبقى يقول: لولا عفوك ما استقمت.
وفي هذا المعنى يتحول العفو من علاج للماضي فقط إلى ضمان للمستقبل؛ فأنا أحتاجه لأثبت، كما أحتاجه لأُغفر.
التكرار أيضًا يفتح باب الأمل؛ فالمُلِحّ على الكريم لا يُرد. وكل إعادة للطلب تعني أن الرجاء ما زال حيًا، وأن العبد لم ييأس.
هكذا تصبح «عفوك» مقامًا دائمًا، يعيش فيه المؤمن بين خوف من التقصير، وطمع في الرحمة، وحياءٍ من كرمٍ لا ينف
ثم تأتي الجملة المؤثرة: «وعظتني فلم أتعظ، وزجرتني فلم أنزجر».
إنها شجاعة الاعتراف، وهي بداية الإصلاح.
«الراحة عند الموت، والعفو عند الحساب».
بعد رحلة الحياة بكل تفاصيلها، هاتان اللحظتان هما الفيصل؛ الراحة عند الانتقال، والعفو عند العرض، وهنا يتجه القلب إلى النهاية ليصحح البداية.
حين يقول العبد: «أنا عبدك… ضعيف فقير إلى رحمتك»
فهو يخلع عن نفسه كل الألقاب التي يتكئ عليها عادة: القوة، المعرفة، الجاه، القدرة، الاستحقاق. يقف مجردًا، بلا حماية إلا الاعتراف بالحاجة.
وهنا تحدث المفارقة العجيبة:
في اللحظة التي يعترف فيها بضعفه، يبدأ مصدر قوته الحقيقي.
في الحياة اليومية نحن نبني هويتنا على ما نملك: وظيفة، شهادة، نفوذ، خبرة، مكانة اجتماعية. هذه الأشياء تعطينا شعورًا بالثبات، لكنها في الحقيقة هشة؛ يمكن أن تزول في لحظة. أما الدعاء فينقل الهوية من ما أملك إلى مَن أحتاج.
الفقير إلى الله ليس معدمًا، بل متصل. هو لا يعتمد على رصيده المحدود، بل على خزائن لا تنفد. لذلك كان الافتقار أعلى المقامات؛ لأنه يجعل القلب دائم الطرق على الباب. كلما ازداد الإنسان شعورًا بالحاجة، ازداد قربًا.
وفي هذا الافتقار كرامة عظيمة؛ لأنك لا تقف على باب بخيل، بل على باب كريم. والكريم يحب أن يُسأل، ويحب أن يُرجى، ويحب أن يرى عبده رافعًا يديه. فالافتقار هنا ليس ذلًا، بل نسبٌ إلى الغنى المطلق.
أخطر ما يصيب الإنسان أن يظن أنه قادر وحده. يأتي الدعاء ليكسر هذا الوهم بلطف، ويذكّره بأنه يحتاج في أنفاسه، وفي صحته، وفي توفيقه، وفي ثباته، وفي خاتمته. حتى الطاعة نفسها تحتاج رحمة.
وحين نقول: «أنا عبدك» فنحن لا نعلن الهزيمة، بل الانتماء. نقول: لست متروكًا، لي رب، لي ملجأ، لي جهة أعود إليها مهما أخطأت. وأي كرامة أعظم من أن يكون لك ربٌّ رحيم تتجه إليه دائمًا؟
من أجمل فقرات الدعاء طلب التبديل أن يتحول الشك إلى إيمان، والقلق إلى طمأنينة، والتعلق بالدنيا إلى رغبة فيما عند الله، والتقصير إلى توبة نصوح.
إنه مشروع تحويل داخلي شامل، لا تجميل سطحي.
«على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك».
الإنسان لا يعيش بلا انتماء، والدعاء يرسخ أن الإيمان موقف عملي، حبٌّ ونصرة واتباع.
«من حلمك تُعصى، ومن كرمك وجودك تُطاع، فكأنك لم تُعص».
حين نقول: «من حلمك تُعصى»
فنحن نعترف أن المعصية ما كانت لتقع لولا أن الله حليم. لو عُجِّلت العقوبة، أو أُخذ الإنسان بذنبه فورًا، لانقطع أكثر الخلق قبل أن يبدأوا. لكن الله يمهل، يستر، يعطي فرصة بعد فرصة، يفتح باب الرجوع مرة بعد مرة. هذا الإمهال ليس إهمالًا، بل تربية، ومساحة ليعود القلب إلى رشده.
ثم نقول: «ومن كرمك وجودك تُطاع».
أي حتى الطاعة نفسها ليست بطولة شخصية خالصة من العبد، بل ثمرة من عطائه سبحانه. هو الذي وفّق، وهو الذي أعان، وهو الذي فتح الباب، وهو الذي حبّب الإيمان إلى القلب. فلو تُرك الإنسان لنفسه، لضعف، ولغلبته شهوته، لكنه حين يُطاع فإنما يُطاع بمدده.
ثم تأتي الذروة المدهشة في المعنى:
«فكأنك لم تُعص».
كيف ذلك؟
لأن الله إذا قَبِل التوبة، محا، بل يبدّل السيئات حسنات. يعامل التائب لا بوصفه مجرمًا سابقًا، بل عبدًا عاد. هنا تتجلى العظمة: ليست المغفرة مجرد إسقاط عقوبة، بل إعادة كرامة.
إنها رحمة لا تكتفي بأن تغلق ملف الذنب، بل تمحو أثره من الذاكرة الحسابية
يختم الدعاء بالصلاة الدائمة غير المحدودة، وكأنها التوقيع الذي يُرفع به العمل، والباب الذي يُرجى به القبول.
ماذا يريد هذا الدعاء أن يصنع فينا؟
الدعاء ليس ألفاظًا تُردَّد، بل إنسانًا يُعاد تشكيله.
حين نتأمل معانيه ندرك أنه لا يريد منّا طقوسًا إضافية، بل يريد ولادة جديدة للروح.
هذا الدعاء يريد أن ينقلنا من رمضان الموروث إلى رمضان المعاش؛ من شهرٍ نعرف مواعيده إلى شهرٍ يعرفنا نحن، من تقويمٍ خارجي إلى انقلابٍ داخلي. إنه لا يطلب أن نمسك عن الطعام فقط، بل أن نمسك عن الغفلة، عن القسوة، عن التأجيل المستمر للتوبة.
يريد أن نحول رمضان من عادةٍ تتكرر كل عام إلى وعيٍ يتجدد كل يوم، ومن إمساكٍ عن المفطرات إلى تزكيةٍ للنوايا، ومن وقتٍ عابر إلى رسالةٍ تحملنا إلى الله. يريد أن تتحول التلاوة من صوتٍ على الشفاه إلى تحوّلٍ في الاتجاه، ومن عدد صفحاتٍ نختمها إلى أبوابٍ تُفتح في داخلنا.
هذا الدعاء يربّي فينا حالة الاستعداد، وأن لا يدخل علينا الشهر ونحن كما نحن.
أن نشعر أن هناك شيئًا يجب أن يتغير: علاقة تحتاج إصلاحًا، ذنبًا يحتاج إقلاعًا، قلبًا يحتاج تنظيفًا، روحًا تحتاج رفعًا.
إنه يريد أن يضعنا أمام حقيقتنا بلا تزيين. فنأتي إلى الله بضعفنا، باعترافنا، بحاجتنا، لا بادعاء الصلاح. ولهذا فإن أجمل ما يصنعه الدعاء فينا أنه يعلّمنا الانكسار المضيء؛ الانكسار الذي لا ييأس، بل يرجو، ولا يهرب، بل يعود.
يريد أن يصنع في داخلنا مشروعًا واضحًا:
• من أكون بعد رمضان؟
• ما الذي يجب أن يتبدل في أخلاقي؟
• أي عادة يجب أن تموت؟
• أي نور يجب أن يولد؟
فالدعاء لا يطلب لحظة عاطفية، بل مسارًا ممتدًا.