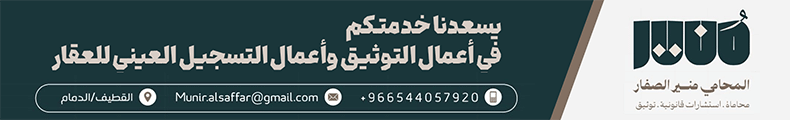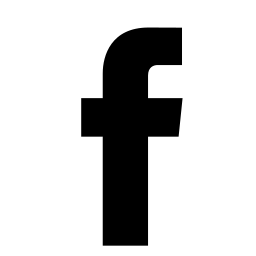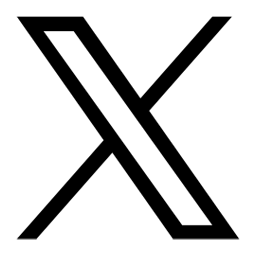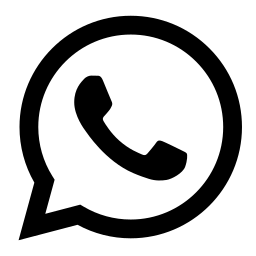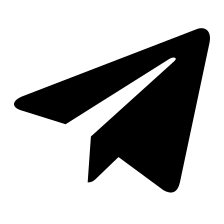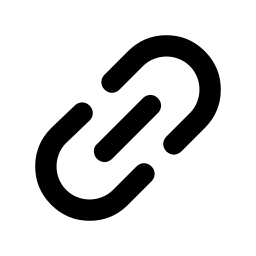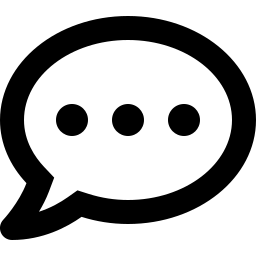من ”الأحساء“ إلى ”تكساس“.. رحلة أديب سعودي لصياغة هوية عابرة للحدود
نادرًا ما يلتقي ضجيج المحركات وهندسة الطاقة برقة القوافي وسرد الرواية، لكن المهندس والأديب السعودي محمد أحمد الياسين استطاع أن يبني جسرًا إبداعيًا يربط بين هذين العالمين المتناقضين في الظاهر، والمتكاملين في رؤيته الفلسفية، متنقلًا بين الرواية والشعر والمقال برؤية تتقاطع فيها المنهجية الهندسية مع الحسّ الجمالي، مستندًا إلى خلفية علمية متخصصة؛ إذ يحمل دبلومًا في الأنظمة الهيدروليكية والنيوماتية من الكلية التقنية بالأحساء، وبكالوريوس في هندسة الميكانيكا والطاقة من جامعة نورث تكساس الأمريكية، ما أضفى على تجربته الأدبية بُعدًا معرفيًا مميزًا..
صدرت له رواية «يعرب» عن نادي الرياض الأدبي عام 2018، إضافة إلى أعمال شعرية وروائية ما تزال في طور المخطوط. كما خاض تجارب ثقافية خارج المملكة، وأسهم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وشارك في فعاليات أدبية واجتماعية داخل الأحساء وخارجها.
في هذا اللقاء الخاص، نبحر مع الياسين في تفاصيل تجربته الثقافية العابرة للحدود، بدءًا من تمثيله للمملكة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وصولًا إلى رؤيته العميقة حول كيفية تأثير ”العقل الهندسي“ في تنظيم بنية النص الأدبي. نناقش معه أسئلة الهوية، وتحديات الكتابة، وكيف يمكن للصوت الداخلي الصادق أن يصنع أفقًا أدبيًا يتجاوز التقليد.
كيف أسهمت خلفيتك الهندسية في تشكيل رؤيتك الأدبية؟ وهل انعكس التفكير المنهجي والتحليلي على أسلوبك في كتابة الرواية والشعر؟
أعتقد أن ممارسة أي عمل لا بد أن تُلقي بظلالها على جوانب الشخصية. الاختصاص العلمي الذي وُفقت لاستكمال متطلباته حركي الطابع، وله مشارب متعددة منها التحليل والمنهجية، وكما تفضلتم نعم، أثر ذلك في جميع النوافذ الأدبية التي أتسلل منها إلى الجمال، سواء في المقالة أو الرواية أو الرؤى. ويظهر هذا الأثر في الهيكلة والفكرة العامة قبل انطلاق الخيال وانثياله في قالبه المرسوم سلفًا.
أستثني من ذلك الشعر؛ فهو، كما أرى، في حالة نفور دائمة من الوقوع في القصد، فهو من يستلّني منه ولست أنا. لكن بما أن الاختصاص تحول إلى ممارسة عملية، أظن أن لغة الأرقام وكيفية التعامل معها تصنع نسيجًا داخليًا ينصهر مع الجمرة الشعورية في قالب يظهر للناقد والمتذوق لمحات تدل على أن كاتب النص له خلفية هندسية. وأنا شخصيًا ألمح ذلك بشدة في قصائد الشعراء المهندسين مثل كبيرنا جاسم الصحيح والصديق العزيز عدنان المناوس.
روايتك «يعرب» تمثل محطة مهمة في تجربتك، فماذا أضافت لك هذه التجربة، وما الذي تعلّمته منها على مستوى البناء السردي والتفاعل مع القرّاء؟
إرهاصات «يعرب» بدأت عام 2015، وقد جاءت بعد رواية أخرى كتبتها ثم سجنتها في الأرشيف، شاكراً لها قدح الفكرة والهمة؛ إذ كانت أرضًا صلبة شرعنت في داخلي الخوض في هذا الفن الشائك والملتبس على الأدباء أكثر من غيرهم لكثرة طرقه واستسهال كتابته.
«يعرب» منحتني مساحة كبيرة للتعبير، وحررتني من قيود الشعر ولحظاته التي لا موعد لها. وهي مرآة لسؤالك الأول؛ إذ كنت أقرأ كثيرًا، وأخرج من قاعات الدرس الهندسي لأكتب، بمعنى أنها ألزمتني بجهد مضاعف تبلور بين الأدب والاختصاص العلمي.
وآسف أن أقول إنني لم أتلقَّ عن «يعرب» إلا ردود فعل ذوقية، وهذا تقصير مني بسبب وجودي خارج البلد، ولم أوفَّق في إقامة الأمسية التي حاول الإخوة في نادي الرياض الأدبي جدولتها بتوجيه من الدكتور خالد الحمود والصديق العزيز القاص والأديب هاني الحجي. لذا فإن ما تعلمته ربما كان قاصرًا، إذ إنه صوت داخلي حاول أن يعرض «يعرب» على ما قرأ من روايات.
ومع ذلك، كان التفاعل الذوقي جيدًا إلى حد ما، وأفدت منه كثيرًا، خصوصًا أنني وُفّقت بأصدقاء لغتهم النقد بذاته لا المجاملات الأخوية.
كانت «يعرب» تجربة جميلة على المستوى الشخصي، والحق أقول إنها قد تكون أقل من المأمول، لكنها تبقى عملاً قال في فترة ما ما أراد محمد الياسين قوله.
كيف توفّق بين اهتمامك بالشعر والرواية والمقال؟ وأي هذه الأجناس تشعر أنه الأقرب إلى صوتك الداخلي وتعبيرك الحقيقي؟
الشعر هو الأقرب إلى صوتي الداخلي؛ لأنه ينثر كل فوضاي في نص، ثم يعود ويشتتني، وكأنها عملية قلق دائم فُرضت عليّ.
أما المقالة فأهرب منها قدر المستطاع، لكنها تسحبني إليها، فأرضخ لها متى ما رأيت أن كلمتي ربما تعالج شيئًا ما. وجل مقالاتي كانت في الشأن الاجتماعي أو الرياضي المتعلق برياضة البلد. ولم أجرؤ على كتابة مقالة أدبية بعد، وذلك لأسباب يطول ذكرها.
أما التعبير الحقيقي داخلي، فلا أراه محصورًا في فن بعينه، بل حريّ به أن يصرخ في أي فن أطرقه، لكن حرارة الشعر وطبيعته تجعله أكثر وضوحًا في الدلالة على من يكتب أشكالاً مختلفة من الأدب.
بحكم إقامتك وتجاربك الثقافية خارج المملكة، ومشاركاتك في التلاقح اللغوي، كيف أثّر الاحتكاك بالثقافات الأخرى في نظرتك للهوية والأدب العربي؟
هذا سؤال جميل ومهم.
الأدب، كونه معينًا عالميًا ولغة متعددة في كائن واحد - أو هكذا أراه - يأخذ بيدك كلما اتسعت نظرتك واغترفت من جهاته المختلفة نحو جهة الجمال وحده. فأنت تعيش الجمال حتى وإن كانت اللغة عائقًا.
عزمت - ويا للأسف - على تعلم اللاتينية لأتفاعل مع قصائد بعض الأصدقاء الشعراء أثناء اللقاءات الأدبية في الجامعة أو خارجها، لكنني لم أتمكن. ومع ذلك كنت أشعر بلذعة ما يقرؤون. وكذلك الإيطالية؛ فقد كنت منجذبًا لفكرة أن تقرأ شاعرًا أو أديبًا بلغته الأم دون وسيط الترجمة.
هذا التلاقح ثري جدًا، وأرجو الله أن أكون قد وُفّقت في الإفادة منه. أما الهوية والأدب العربي فهما تكوين أولي وأساس متين في داخلي، وقد تأثرا بشكل إيجابي حين انفتحا على أصوات وهويات متعددة، فشكّلا نوافذ ذوقية ومعرفية جديدة لا تكف عن أن تقول: زدني، لنرتقي؛ فالأفق الهوياتي رحب، والأدب كائن متعدد اللغات.
ما المشاريع الأدبية التي تعمل عليها حاليًا؟ وما الطموح الذي تسعى إلى تحقيقه في المرحلة القادمة لخدمة المشهد الثقافي في الحليلة والأحساء والوطن عمومًا؟
لا أخفيكم أنني حذر جدًا في مسألة الطباعة والنشر، رغم إلحاح كبير منذ فترة طويلة من بعض الأصدقاء الشعراء والأدباء.
فيما يخص الرواية، لدي مخطوطتان فرغت منهما منذ سنوات، ولعلنا نوفَّق إلى نشرهما في الوقت المناسب.
أما الشعر، ولله الحمد، فقد عزمت قبل فترة وبدأت العمل على مراجعة ديوان شعري، وسيُنشر - بحول الله - قريبًا، وأسأل الله التوفيق في ذلك.
وبما أنك تنتمي إلى أسرة متدينة عُرفت باهتمامها بالقرآن الكريم والدين، نضع بين يديك مجموعة من الأسئلة التي تتناول العلاقة بين الأدب والدين، لعلها تفتح أفقًا أوسع للحوار والتأمل.
هل ترى أن التديّن يفرض على الأديب قيودًا فكرية قد تحد من حريته التعبيرية، أم أنه يمنحه إطارًا أخلاقيًا يوجّه إبداعه دون أن يقيّده؟
نعم أستاذنا، البيئة تلعب دورًا كبيرًا، خصوصًا في البواكير، وقد تحد بشكل واضح من حرية التعبير لدى المبدع؛ إذ يكون ما يزال في مراحل الانصهار والتبلور. لكن مع نمو عقلية المبدع يتشكل لديه إطار أخلاقي ينطلق من خلاله بحسب المتانة التي تأسس عليها.
إلى أي مدى يمكن للتجربة الروحية والإيمانية أن تُثري الخيال الأدبي وتمنحه عمقًا إنسانيًا ومعنويًا أكبر؟
أرى أنها تلعب دورًا كبيرًا؛ لأن الدين في ذاته منظِّم شعوري وعقلي، ولا يستطيع الإنسان الطبيعي أن يعيش منفصلًا عنه. فالتجربة الروحية والإيمانية منطقة ثراء بحد ذاتها، ودافع حركي للإنسان المتعلق بالحق سبحانه. وما الأدب في جوهره إلا محاكاة لهذا الكون الفسيح الذي لم يُخلق باطلًا.
الخيال الأدبي له مفاتيح كثيرة، أهمها التأمل، ولا أظن متأملاً يكون بمعزل عن القدرة الإلهية الإبداعية، حتى وإن كان لا يؤمن بدين أو شريعة؛ فبقدر ما يتأمل يكون متعلّقًا بالقوة التي رسمت هذا الجمال، وإن كان لا يصرّح بالإيمان بها.
هل تكمن الإشكالية في التديّن ذاته، أم في الفهم الضيّق للدين الذي قد يحوّله إلى نوع من الرقابة الداخلية على الكاتب؟
أعتقد أن الإشكالية ليست في التديّن، بل - كما تفضلتم - في الفهم الضيق للدين، حين يتحول إلى طقوس وحالات منغلقة تحول بين المبدع وطرائق التعبير. فالرقابة الداخلية هنا قد لا تكون من قوة الإيمان، بقدر ما تكون نتيجة ضيق الأفق وضعف الانفتاح على الجمال الذي هو - في جوهره - دين.
كيف يمكن للأديب المتديّن أن يوازن بين الصدق الفني ومتطلبات القيم الدينية دون الوقوع في المباشرة أو الوعظية؟
لا أظن أن الصدق الفني يتعارض مع القيم الدينية بشكل عام؛ فالدين حاضنة للأدب، بل هو الأدب الأكبر كما أعتقد. أما المباشرة والوعظية فهما - في نظري - نتيجة ضيق في الأفق، أو أسلوب يفرضه الأديب على نفسه خوفًا من المحظور في اعتقاده، أو ربما تفرضه عليه قيوده الاجتماعية، كما نرى لدى بعض الشعراء وأهل النظم، كالإمام الشافعي على سبيل المثال لا الحصر.
هل تعتقد أن الأدب ذي البعد الأخلاقي أقل جمالية من الأدب المتحرر من الضوابط، أم أن الجودة الفنية مستقلة عن هذا التصنيف؟
أعتقد أن الجودة الفنية هي الحكم هنا.
هل يمكن للالتزام القيمي أن يدفع الكاتب إلى ابتكار أساليب رمزية وفنية أعمق بدل اللجوء إلى الصدمة أو الإثارة السطحية؟
أعتقد أن الصدمة أو الإثارة السطحية لا يُعوَّل عليهما في كتابة نص إبداعي. ما يثري الإبداع هو القيمة الفنية بجميع جوانبها، سواء ارتبطت بالالتزام القيمي أم لم ترتبط. ما دام الأفق رحبًا والنظرة غير أحادية، يستطيع المبدع - أيًا كان الشكل الإبداعي الذي يطرقه - أن يؤسس ويبتكر منطلقًا في صوته الخاص.
كيف تنظر إلى تجارب أدباء مؤمنين أو ذوي نزعة روحية تركوا أثرًا بارزًا في الأدب العربي والعالمي؟ وهل كان إيمانهم مصدر قوة أم عائقًا أمام إبداعهم؟
هناك الكثير من التجارب المؤسسة، كلٌّ في شكله الإبداعي وبأدواته. ولا أرى ضيرًا في فلتاتهم الفكرية أو المفردات التي طرقوها، وأعي تمامًا اصطدامهم بالمجتمعات المتدينة. لكن هذا يقع في باب الصدمات الثقافية؛ إذ كيف لهذا المبدع أن ينهض بفكرة معينة أو يستخدم مفردات تُعد محرّمة أو يشير إلى محظورات في مجتمعه؟
البعض كان إيمانهم مصدر قوة، والبعض كان عائقًا، وهذا هو الأفق حين يضيق أو يتسع.
برأيك، هل يتقبّل القارئ المعاصر الأدب ذي البعد الديني والروحي، أم يميل أكثر إلى النصوص المتحرّرة من المرجعيات القيمية؟
أعتقد أن ذلك منوط بنظرته إلى الدين وروحيته؛ فالتقبّل هنا نسبي. خصوصًا أن النصوص المتحررة لم تنقطع منذ انبثاق الأدب. والمفارقة أن المبدع المعاصر لا يُستقبل غالبًا كما استُقبل السالفون، وهكذا دواليك.
نعم، هناك من يأنف من قراءة الأدب المتحرر، ولا دخل هنا للأفق؛ إذ إن الإنسان القيمي يرى نفسه بين خيارين: القيم التي يدين بها، أو الأدب المتحرر الذي يراه انفلاتًا أخلاقيًا، وتلك وجهة نظر تُحترم.
هل يمكن أن يكون التديّن مصدرًا للقلق الوجودي والأسئلة الكبرى التي تُعد منطلقًا لكثير من الأعمال الإبداعية العميقة؟
نعم، أظنه كذلك. فالتدين في ذاته جمال وثراء ومولّد كبير للقلق والسؤال. لكن ذلك منوط بكيفيته لدى الإنسان وديناميكيته؛ فالمتدين الجامد لا يصلح له الخوض في القلق الوجودي والأسئلة الكبرى، لأنها قد تتحول لديه إلى مصدر ضياع وهدر عقلي وقلبي يكبو به ولا يرفعه.
في تصورك، ما الصورة المثلى للأديب المتديّن: هل هو واعظ يكتب، أم مبدع يحمل قيمه في داخله ويجسّدها فنيًا دون أن يفرضها مباشرة على النص؟
أعتقد أن الوعظ لا يصنع أدبًا - إذا استثنينا المعصوم - أما المبدع فلا بد أن تكون له قيم، وهو حر في التشكيل والانطلاق. ولي، كمتلقٍ، القيمة الفنية التي تعلو على منطلقاته ومنطلقاتي على حد سواء.
هل تعتقد أن القيم الدينية يمكن أن تشكّل مصدر إلهام جمالي للنص الأدبي، لا مجرد إطار أخلاقي يضبطه؟
أعتقد أن القيم، بمفهومها الرحب، هي مصدر إلهام جمالي. أما الأطر فتتشكل بحسب إيماننا وفهمنا العميق لها، وكيفية انطلاقنا منها.
هل هناك موضوعات أو مناطق شعورية يتحفّظ الأديب المتديّن على طرقها، أم أن الفن الصادق يملك مشروعيته في تناول كل شيء بأسلوب راقٍ؟
أظن أن الأديب في مجتمعاتنا يظل رهينة المحيط ما دام يرى نفسه أديبًا متدينًا، في حين أن اللغة تسع الجميع، والأدوات كلما تفرعت واتسعت مكّنت المبدع من التعبير عن صوته الداخلي.
وأزعم أن الأديب لا بد له من التخفف من عبء المحيط ليتمكن من إيصال رسائله وفوضاه الداخلية بأدب راقٍ.
إلى أي مدى يمكن للرمز والأسطورة والتأويل أن تكون أدوات فنية تمكّن الأديب المتديّن من التعبير العميق دون الوقوع في المباشرة؟
أعتقد أن هذا نسبي، ويتوقف على فهمنا واستيعابنا للرموز والأساطير.
على سبيل المثال، إذا قرأنا نصًا إبداعيًا يتناول المعصوم لدى جاسم الصحيح، فإننا نبحر معه في فهمه العميق واستيعابه الإيماني الرحب. على العكس من بعض النصوص التي قد تهبط بمعانيها.
هل ترى أن الأدب الروحي أو الإيماني بحاجة إلى تجديد لغته وأدواته ليواكب القارئ المعاصر، أم أن المشكلة في التلقي لا في الكتابة؟
أعتقد أن الإشكالية مشتركة؛ فالأديب مطالب بتنمية أدواته قبالة إيمانه الروحي، بحكم أننا نؤمن بكمال الدين، والكامل لا ينقصه تقادم الزمن. أما المتلقي، فإن كانت لديه رغبة صادقة، فعليه أن يبحر إلى مناطق الاستيعاب، لا أن يبقى على الشاطئ ويصدر أحكامًا محدودة.
كيف ينعكس حضور القرآن الكريم واللغة الدينية في ذائقة الأديب الأسلوبية من حيث الإيقاع والصورة والبناء البلاغي؟
في البواكير قال لي والدي: اقرأ ما شئت، لكن اجعل القرآن الكريم رفيقك قراءةً واستماعًا وتدبرًا في تفاسيره لتستقيم لغتك بجميع خصائصها، وكذلك نصحني مشكورًا الدكتور أبو باسل البراهيم.
القرآن الكريم، ثم نهج البلاغة، فالصحيفة السجادية، فكلام المعصوم، زاد عظيم للأديب أيا كانت نظرته للدين.
هل يمكن القول إن الالتزام القيمي يمنح الكاتب حرية داخلية أكبر لأنه متصالح مع ذاته، أم أنه يحمّله مسؤولية مضاعفة في كل كلمة يكتبها؟
أعتقد أن القيم متى ما كانت عميقة فهي مصدر حرية، والعكس صحيح. أما المسؤولية، فالمبدع غير المسؤول أظنه جانب الصواب. ومع تبلور التجربة يصبح المبدع الصادق أكثر دقة في اختيار كلماته بوصفها أداة فاعلة في النص.
برأيك، ما الفرق بين الأدب الذي ينطلق من تجربة إيمانية حقيقية، وبين الأدب الذي يتزيّن بالمفردات الدينية شكليًا دون عمق روحي؟
التزيين الشكلي دون عمق يؤدي إلى نص رديء ومكشوف وغير قابل للبقاء. الصوت الداخلي غالب على أمر المبدع، فهو يُظهر الصدق والزيف. لذلك على المبدع أن يُنمّي أدواته ويصعّد تجربته.
هل مررت بتجربة شعرت فيها أن إيمانك أو رؤيتك القيمية غيّرت مسار نص كنت تكتبه أو أعادت صياغته بالكامل؟
قد يحدث ذلك في البواكير؛ إذ يكون المبدع في مرحلة صراع مع نقص الأدوات. لكن مع تقادم التجربة، وخصوصًا الشعرية، فإن المبدع تكتبه ثقافته المتراكمة والأفكار التي آمن بها.
أما إعادة صياغة النص الشعري فإني أراها عملية اغتيال للنص، ولا أقصد هنا التشذيب.
كيف يمكن للأديب المتديّن أن يخاطب قارئًا غير متديّن دون أن يفقد صدقه الداخلي أو يتحوّل إلى خطاب إقصائي؟
متى ما كان مؤمنًا بأدواته، صادقًا في عمقه وفهمه للتدين، ومنفتحًا على الآخر، فإنه قادر على المخاطبة.
لو طُلب منك تعريف الأدب المؤمن أو الأدب القيمي في عبارة واحدة، فكيف تصوغه بحيث يجمع بين الجمال والحرية والمسؤولية؟
أعتقد أن الأدب أفق رحب، وهذه الخطوط فُرضت لعوامل اجتماعية ودينية ولا دينية. والإنسان بفطرته السليمة صانع جمال، والأديب - مهما كان توجهه - ينبغي أن يكون محطة ثراء وبناء. خطه ليس هو الأهم بقدر أهمية المادة التي نتجت عن صوته الخاص.
الخاتمة:
هكذا تتكشف لنا تجربة محمد أحمد الياسين بوصفها رحلة بحث دائمة عن التوازن؛ بين العقل والروح، بين الانتماء والانفتاح، وبين القيم والحرية الفنية. تجربة تؤكد أن الأدب ليس موقفًا مسبقًا بقدر ما هو فعل اكتشاف مستمر، وأن الكاتب الحقيقي لا يتوقف عن إعادة تعريف نفسه مع كل نص جديد.
يبقى الياسين صوتًا يسعى إلى تعميق أدواته، وإلى أن يكتب ما يؤمن به دون افتعال، وأن يترك للقارئ مساحة التأويل والمشاركة. وبين مخطوطات تنتظر النشر، وديوان يتهيأ للخروج إلى النور، تتواصل الحكاية، ويبقى الأمل بأن يحمل القادم مزيدًا من النضج والاتساع لهذا المشروع الإبداعي.