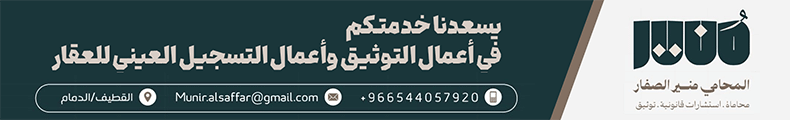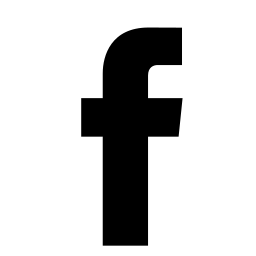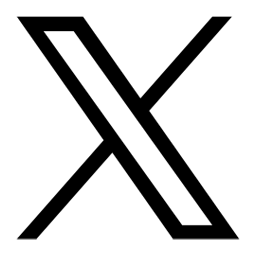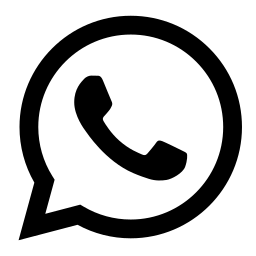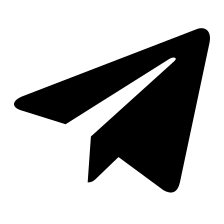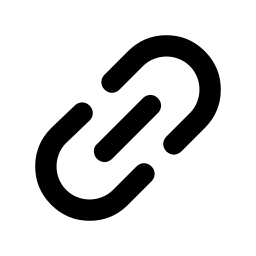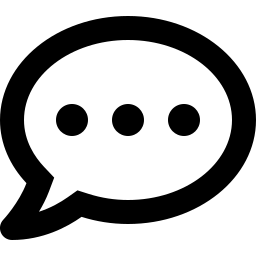ظاهرة الطلاق
لم يعد الزواج في وعي كثير من شباب اليوم مشروعَ حياةٍ طويل الأمد، بقدر ما أصبح تجربةً شخصية يُنتظر منها أن تُشبع الاحتياج العاطفي سريعًا وتمنح شعورًا دائمًا بالرضا. اليوم يدخل الشاب والشابة إلى عقدٍ كان يُنظر إليه قديمًا على أنه ميثاقًا غليظًا، محمّلين بتوقعات كبيرة، لكن بأدوات نفسية هشة، وصبرٍ محدود، وقدرة ضعيفة على احتمال الخلاف.
في السابق، نشأ الإنسان في بيئة تُقدّس الارتباط الزوجي، لا لأنه يخلو من المشقة، بل لأنه يُدار بمنطق التحمل والمشاركة وتقاسم الأعباء. كان الطلاق أبغض الحلال فعلًا، لا نصًا يُتلى، بل شعورًا جمعيًا يُحيط الكلمة بهالة من الخوف والتريّث. أما اليوم، فقد تآكل هذا الشعور بهدوء، حتى باتت كلمة الطلاق سهلة على اللسان، تُقال في لحظة انفعال، وكأنها قرار عابر لا يترتب عليه كسر طويل الأمد.
هذا التحوّل لا يمكن فهمه بمعزل عن طبيعة الحياة العصرية التي نشأ فيها الجيل الحالي. الرفاه المادي، سهولة الوصول إلى البدائل، وثقافة الاستهلاك، أعادت تشكيل علاقة الإنسان بكل شيء، بما في ذلك العلاقات الإنسانية. ما لا يعمل يُستبدل، وما يُتعب يُتجاوز، وما لا يُشبه التوقعات يُلغى. وهكذا انتقل هذا المنطق إلى الزواج، فأصبح الخلاف دليل فشل، لا مرحلة طبيعية، وأصبح الصبر عبئًا لا فضيلة.
ولعبت الشاشة، بما تبثّه من أفلام ومسلسلات رومانسية مُنمَّقة، دورًا عميقًا في تشويه التصوّر الواقعي للعلاقة الزوجية، إذ قدّمت نموذجًا عاطفيًا مثاليًا يخلو من المتاعب، ويُدار فيه الخلاف بلا كلفة، وتُصوَّر فيه السعادة كحالة دائمة لا يعتريها فتور. ومع التعرّض المستمر لهذا الخطاب البصري، وجد كثير من الشباب أنفسهم يعيشون حالة نفسية مضطربة، تتأرجح بين الإحساس بالعجز عن مجاراة ما يشاهدونه، وبين شعور خفي بأنهم لم يُوفَّقوا في اختيار الشريك القادر على صناعة تلك الأجواء الحالمة. وبدل أن يُعاد النظر في زيف الصورة المعروضة، يُوجَّه الشك إلى العلاقة ذاتها، فتتحوّل خيبة الوهم إلى قناعة خاطئة بأن الخلل في الزواج، لا في التوقعات التي صاغتها الشاشة.
يضاف إلى ذلك سوء فهم شائع لمفهوم الحرية الفردية، حيث يُنظر إلى الزواج أحيانًا بوصفه مساحة لتحقيق الذات فقط، لا شراكة تفرض التنازل المتبادل. الشاب يريد شريكة تُشبه ما في مخيلته، والشابة تريد زوجًا يُشبه ما رأته وسمعته، وحين يتبيّن أن الواقع أقل بريقًا، يبدأ التآكل الصامت للعلاقة إلى أن يصل بهما الحال إلى التباعد.
كما أنه لا يمكن إغفال أثر التدخلات الخارجية، سواء من الأسرة أو الأصدقاء، التي كثيرًا ما تُغذّي الانحياز بدل الإصلاح، وتُضخّم الخلافات بدل احتوائها، فضلًا عن الضغوط المالية والاجتماعية التي تُفاقم التوتر وتدفع الطرفين إلى قرارات متعجلة، بُنيت على انفعال لا على تعقّل.
واقعيًا نحن لسنا أمام أزمة أخلاق بقدر ما نحن أمام أزمة وعي. أزمة في فهم معنى الزواج، وحدود التوقع، وطبيعة الإنسان. فالعلاقة الزوجية لا تُقاس بمدى خلوّها من المشكلات، بل بقدرة أطرافها على إدارتها. ولا تُبنى على الاندفاع العاطفي وحده، بل على نضجٍ يدرك أن المودّة قد تضعف، وأن الرحمة هي ما يُبقي البيوت قائمة.
من هنا، تتأكد مسؤولية الأسرة، والمؤسسات التربوية والمجتمعية، في إعادة تصحيح المفاهيم، وتفكيك الصور الوهمية، وتعليم الشباب أن عبارة «نعم قبلت» ليست لحظة فرح آنية، بل التزام طويل الأمد، ومسؤولية لا تُختزل في الشعور اللحظي والذي قد لايتعدى أياماً أو أشهر قليلة.