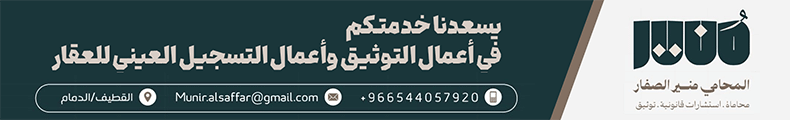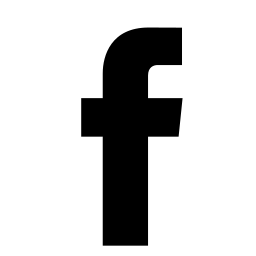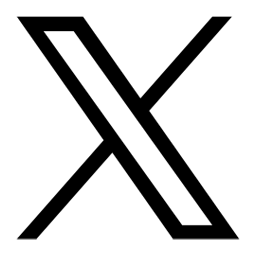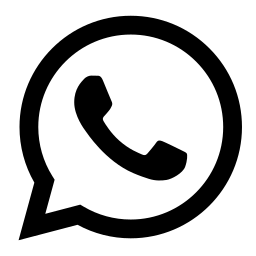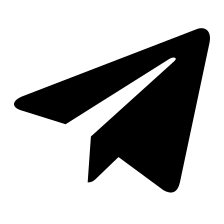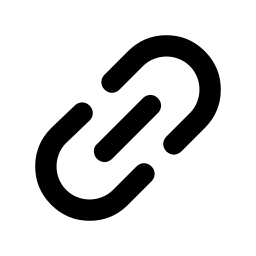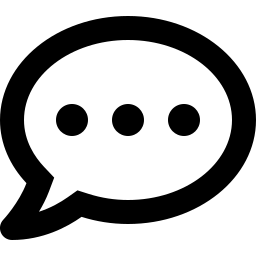وحدة الأب… حين تكون القسوة من الأقربين
اجتمع مع أولاده كعادته في ليلة الجمعة، ليلة اعتاد أن تكون دافئة، تفوح منها رائحة القهوة، ويؤنسها صوت القرآن الخافت، لكن هذه الليلة كانت مختلفة.
بدأ حديثه بهدوء:
«اليوم هو آخر يوم لي في العمل… لقد تقاعدت».
تنهد من أعماق قلبه، كأن الزفير يحمل معه أعوامًا من التعب المؤجل، وقال بصوتٍ يختلط فيه الفخر بالتعب:
«ثلاث وثلاثون سنة انتهت…سنوات عمل واجتهاد وخدمة، أفتخر بها».
قال ابنه سعيد مبتسمًا:
«أعطاك الله الصحة والعافية يا أبي، والقادم أفضل إن شاء الله…كنت نعم الموظف المثالي».
وقالت بناته الثلاث:
«الآن عليك أن ترتاح من زحمة الشوارع، ومن عناء الذهاب والإياب».
ابتسم الأب وقال:
«الحمد لله على كل حال».
ابتسامة قصيرة… لم تصل إلى عينيه.
ثم سكت قليلًا، سكونٌ ثقيل، كأن الكلمات تتردد في صدره قبل أن تخرج، وأضاف:
«هناك موضوع أودّ أن أستشيركم فيه».
بادرت الكبرى بسرعة:
«هل ستبدأ ببناء الأرض من مكافأة التقاعد؟»
وقالت الوسطى:
«أبي، زوجي يحتاج بعض المال لإكمال تشطيب الشقة».
وقالت الصغرى بلا تردد:
«وأنا أريد سيارة».
تساقطت الطلبات كما تتساقط الأحجار على صدرٍ مُتعب.
نظر إليهم سعيد بدهشة وقال:
«ما بكم؟ هل هكذا نتقاسم المال؟ دعوا أبي يكمل حديثه».
قال الأب بصوتٍ هادئ، هدوء من تعلّم الصبر طويلًا، لكنه مثقل بالسنين:
«نعم… كل واحد منكم يفكر في مستقبله، وهذا من حقكم. لكن أنا أيضًا أريد أن أفكر في مستقبلي، وفيما بقي لي من عمري».
توقف لحظة، كأنه يستجمع شجاعته، ثم قال:
«بعد وفاة والدتكم، بقيت أربيكم…اثنتا عشرة سنة مضت، تزوّجتم، وأنجبتم، والحمد لله».
رفع رأسه وقال:
«أنا يا أولاد… أفكر أن أتزوج».
كانت الكلمة كقنبلة سقطت في وسط البيت.
تبدل الهواء، وتصلب الوجوه، وانكمش الأمل فجأة.
انتفضت الكبرى:
«ما هذا الكلام يا أبي؟ تتزوج؟! كيف تسمح لامرأة غريبة أن تحتل مكانة أمّنا المرحومة؟»
وقالت الوسطى بحزم:
«لا يا أبي… لا نقبل».
أما الصغرى…
فبقيت صامتة.
وصمتها لم يكن رحمة، بل حيادًا موجعًا.
قال سعيد متألمًا:
«هل نحن قصّرنا معك يا أبي؟»
قال الأب:
«لا… لم تقصروا، ولكن أنا…»
قاطعته الكبرى بانفعال:
«قلت لا، وألف لا! لن أسمح بدخول امرأة غريبة هذا البيت».
ارتفعت الأصوات، تشابكت الكلمات، تبادل الاتهام، غضب، وبكاء، واحتدام.
والأب…كان في قلب العاصفة، وحيدًا.
كأن الجميع يتكلم، إلا من يحق له الكلام.
نظر إليهم طويلًا، نظرة وداعٍ لم يفهموها، لم يقل شيئًا.
وقف بهدوء، هدوء من كُسر داخله، غادر الصالة إلى غرفته الخاصة، وأغلق الباب.
وبقي الأولاد في نقاشهم الحاد، كأن شيئًا لم ينكسر في تلك اللحظة.
في الصباح، كان الفجر صامتًا على غير عادته، ذهب سعيد ليوقظ والده لصلاة الفجر.
فتح الباب بهدوء…
فوجده يحتضن صورة والدته، ودمعة متجمّدة على عينه.
كأن القلب توقّف وهو ممسك بآخر ذكرى أمان.
حرّكه…
صرخ:
«أبي… استيقظ!»
لكن…
لم يتحرّك أبو سعيد.
صرخ سعيد وقد خنق صوته الذهول:
«يا ويلنا… لقد…»
وسقطت الحقيقة ثقيلة، كحجرٍ في صدر البيت كله، حين أدركوا متأخرين أن القلب الذي طلب ونسًا، لم يحتمل مزيدًا من الوحدة.
رحل…
قبل أن يتزوج، وقبل أن يجد من يسمعه، وقبل أن يُنصَف.
وبقي السؤال معلقًا في الصمت:
هل كان طلبه كثيرًا؟
أم أن القسوة…
حين تأتي من الأقربين، تقتل بصمت؟