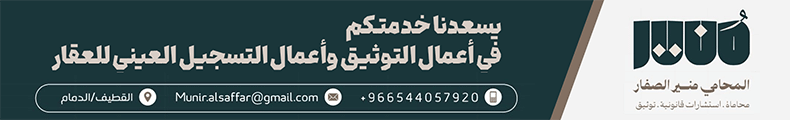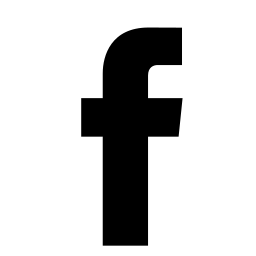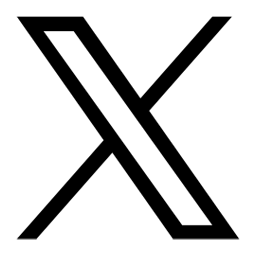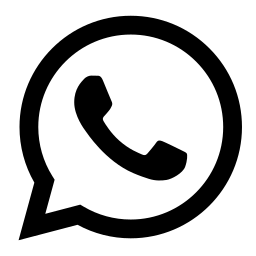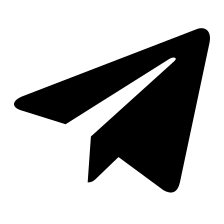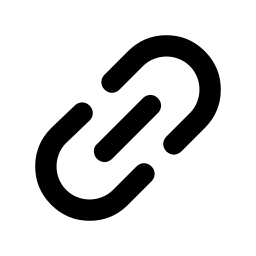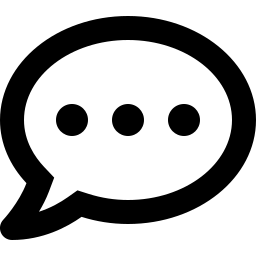من عبق الماضي: السيارات في القطيف ”ذاكرة النقل“
لطالما شكّل الطريق في القطيف أكثر من مجرد مسار عبور، فهو سجل حي لتاريخ المدينة ومرآة لتحول المجتمع عبر الزمن، فالطرقات القديمة «الأزقة» الضيقة كانت شاهدة على حركة العربات «القواري» والحيوانات وحمل البضائع أو الأغراض التي تُجلب من مكان إلى مكان آخر، وأيضًا مرور القوافل التجارية، وهذا شكّل جزءًا أساسا من الاعتماد على العربات التي تجرها الخيول أو الحمير أو البغال، وكانت هذه الوسائل تنقل البضائع والمحاصيل والماء وتربط بين القرى والأسواق والمزارع، كما كانت الأحياء القديمة تتلون حول مسارات الحركة هذه.
حتى عبور البحر كان جزءًا من هذه المنظومة، إذ كان السكان يعتمدون على القوارب الخشبية لعبور الممرات المائية مثل جزيرة تاروت، بينما كانت الحيوانات تسحب العربات على اليابسة، خاصة عند انخفاض منسوب المياه أو في المناطق الساحلية التي يصعب الوصول إليها بالطرق البرية، وفي الأزقة وعلى امتداد مزارع النخيل كانت تُروى حكايات من الصبر والبطء والألفة بين الإنسان والطبيعة، في زمن كانت فيه الحركة البطيئة وسيلة للتواصل الاجتماعي والمعيشة اليومية.
في بدايات القرن العشرين وما قبله كانت العربات التي تجرها الخيول أو الحمير أو البغال الوسيلة الرئيسة للنقل في القطيف، حيث تحمل هذه العربات البضائع والمحاصيل والماء، وأيضًا نقلت العائلات بين القرى والأسواق، وكانت جزءًا أساسيًا من النظام الاقتصادي والاجتماعي المحلي، وكذلك شكّلت الطرق الترابية ومسارات القرى والمتنزهات الزراعية جزءًا من تنظيم النقل، حيث كانت كل عائلة أو تاجر يملك عربته الخاصة أو يعتمد على حلفاء تجاريين لتأمين النقل بين الواحات والأسواق.
هذه الوسائل تعكس الترابط بين الناس وتكيّفهم مع البيئة، وتُظهر مدى الصبر والمهارة المطلوبة للتحرك في ظروف صعبة مثل الطرق الرملية أو الممرات الطينية بعد هطول الأمطار، وكانت الطقوس اليومية جزءًا من ارتباط العمل الزراعي بالفلاح والنشاط التجاري بالتاجر.
دخلت السيارات إلى الجزيرة العربية في القرن العشرين، وكانت القطيف من المدن التي شهدت هذه النقلة التكنولوجية تدريجيًا، حيث بدأت التحولات في النقل مع المدن الكبرى مثل الرياض وجدة أولًا، قبل أن تصل تدريجيًا إلى المنطقة الشرقية والقطيف، وتشير المصادر التاريخية إلى أن أول سيارة وصلت إلى السعودية بين عامي 1915-1920 كانت هدية من المسؤولين العثمانيين أو التجار للأمراء المحليين، وكانت غالبًا من طراز مرسيدس بنز، وفي الوقت نفسه أثارت دهشة السكان لصوت محركها وشكلها المعدني الغريب في مجتمع لم يكن يعرف الميكانيكا الحديثة بعد.
في عام 1921 وصلت سيارات إلى الرياض من بينها فورد طراز T ضمن أسطول الملك عبد العزيز، وكانت بداية التعود على المركبات الميكانيكية في المدن الكبرى، وكانت السيارات تُستخدم أولًا لأغراض النخبة والتنقلات الرسمية، وخلال العشرينيات والثلاثينيات بدأت السيارات تنتشر تدريجيًا في المدن الكبرى رغم صعوبة الطرق وعدم توفر البنية التحتية، فقد كانت غالبية المركبات تغوص في الرمال أو تتعطل في الطرق الترابية، مما شكّل تحديًا كبيرًا للسائقين المحليين.
وصلت السيارات الأولى إلى القطيف في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات، عندما بدأ التجار الأثرياء وأصحاب المشاريع التجارية بتجربة المركبات الحديثة لتسهيل النقل بين القرى والأسواق، وغالبًا ما كانت السيارات تواجه صعوبة في الحركة على الطرق الترابية أو الرملية، وكان من الضروري للسائقين معرفة الطرق المحلية ومهارات إدارة المركبة في تلك الظروف الصعبة.
ومع مرور الوقت أصبح استخدام السيارات أكثر انتظامًا، خاصة لنقل البضائع والركاب بين الأسواق والمزارع ومن منطقة إلى أخرى، وبدأت المركبات الحديثة تفرض نفسها تدريجيًا على المشهد الاجتماعي لتصبح جزءًا من النسيج اليومي للحياة في القطيف.
قبل انتشار السيارات بشكل واسع دخلت الدراجة الهوائية «السيكل» منتصف القرن العشرين إلى الأزقة الضيقة في القطيف، وكانت وسيلة تنقل خفيفة للشباب والأطفال، وأصبحت سجلًا أوليًا للتعود على العجلات دون الحاجة إلى الحيوانات، وقد شكّلت الدراجة مرحلة انتقالية اجتماعية مهمة ساعدت السكان على تقبل الحركة الذاتية والاعتماد على وسائل نقل ميكانيكية قبل أن تصبح السيارات الوسيلة الأساسية.
وفي الوقت نفسه بدأت القطيف تشق طريقها نحو التحول الحضاري، حيث عُبّدت الطرق وشُقّت الشوارع وتوسعت وربطت الأحياء والأسواق والمزارع، وظهرت محلات تصليح السيارات ومواقفها أمام البيوت، وأصبحت السيارة جزءًا من الحياة اليومية، وسهّلت الطرق التنقل إلى المدارس وزيارة الأقارب والأسواق البعيدة، وساهمت في تغيير طبيعة العلاقات الاجتماعية وتقليص المسافة بين القرى والمدن، كما ساعدت السيارات في فتح المدينة على العالم الخارجي وربطها بالمناطق الأخرى من المملكة.
اليوم تُعرض السيارات الكلاسيكية في المهرجانات التراثية، فقد أصبحت رمزًا للذاكرة الجماعية، وأصبح السجل المرئي والتوثيقي للسيارات في القطيف جزءًا من التراث المحلي، ويعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للمدينة، ويربط بين الماضي والحاضر، ويُظهر كيف انتقل المجتمع من الحياة البطيئة المرتبطة بالعربات والحيوانات إلى الحركة الحديثة باستخدام السيارات والشوارع المعبدة.
من بين عبق الماضي والحاضر، رائحة البترول «الديزل، البنزين، الزيت» في المحركات القديمة، وعطر النخيل في المزارع، تحكي القطيف قصة زمن مضى من العربات والحيوانات إلى الدراجة الهوائية ثم السيارات، ومن الطرق الترابية إلى الشوارع المعبدة. أجل، لقد سجلت وسائل النقل تلك التحولات في المجتمع القطيفي، من الحياة البطيئة المرتبطة بالزراعة وصيد الأسماك والحرف المهنية البسيطة والأسواق المحلية إلى الحركة السريعة والاتصال بالمدن الأخرى، فتظل السيارات رمزًا للحداثة والتاريخ في آن واحد، ورفيقة للذاكرة الجماعية للأجيال، وشاهدة على عبق الماضي وروح التحول الحضري.