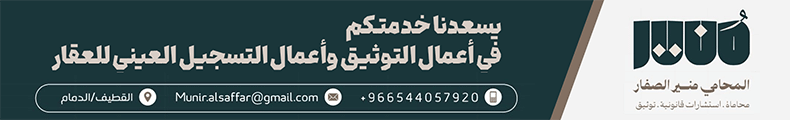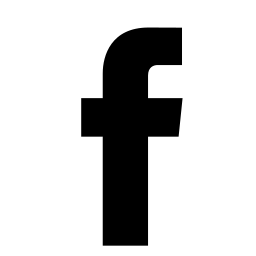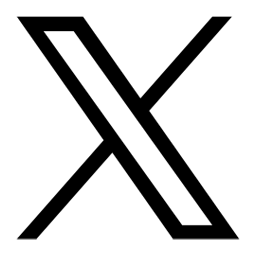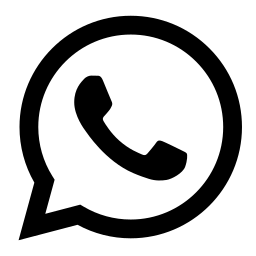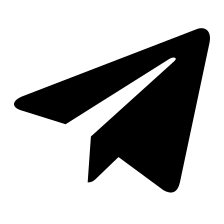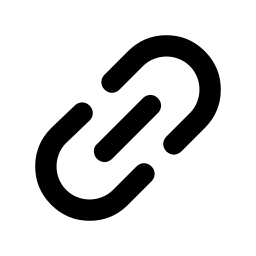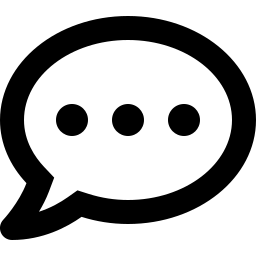السيدة خديجة… سيدة التأسيس وأمّ الرسالة الخالدة
في زوايا التاريخ الهادئة، حيث لا ضجيج ولا صخب، تقف بعض العظمة في صمت… صمتٍ يصنع التحوّل الحقيقي دون أن يلتفت إليه كثيرون. وهناك، في قلب البدايات الأولى للإسلام، تقف السيدة خديجة  ، لا كاسمٍ في سيرة، بل كنبضٍ في أصل الرسالة.
، لا كاسمٍ في سيرة، بل كنبضٍ في أصل الرسالة.
ومع عظمة هذا المقام، يظل السؤال حاضرًا في القلب قبل اللسان:
لماذا لا تتحول سيرة السيدة خديجة  إلى حالة حيّة في وجدان المسلمين، تليق بمكانتها الكبرى في تأسيس الإسلام؟
إلى حالة حيّة في وجدان المسلمين، تليق بمكانتها الكبرى في تأسيس الإسلام؟
كانت السيدة خديجة  الإيمان قبل أن يكون هناك جمهور من المؤمنين، وكانت السند حين كان الطريق موحشًا، وكانت الطمأنينة حين ارتجف الكون لأول مرة بنزول الوحي. عاد النبي ﷺ من غار حراء مثقلاً بدهشة النور، فكانت السيدة خديجة
الإيمان قبل أن يكون هناك جمهور من المؤمنين، وكانت السند حين كان الطريق موحشًا، وكانت الطمأنينة حين ارتجف الكون لأول مرة بنزول الوحي. عاد النبي ﷺ من غار حراء مثقلاً بدهشة النور، فكانت السيدة خديجة  الحضن الذي يستقبل الخوف باليقين، والاضطراب بالثبات، والرهبة بكلمة خالدة: «كلا والله، لا يخزيك الله أبدًا».
الحضن الذي يستقبل الخوف باليقين، والاضطراب بالثبات، والرهبة بكلمة خالدة: «كلا والله، لا يخزيك الله أبدًا».
لم تكن السيدة خديجة  مجرد زوجة، بل كانت شريكة الرسالة في أصعب فصولها. آمنت حين تردد غيرها، وصدّقت حين كذّب الناس، وبذلت مالها كله حين كان الإسلام في أمسّ الحاجة إلى من يحرسه بالاقتصاد قبل أن يحرسه بالسيوف. خسرت تجارتها، ومكانتها، ورفاهيتها، لكنها ربحت الخلود في ضمير الدعوة.
مجرد زوجة، بل كانت شريكة الرسالة في أصعب فصولها. آمنت حين تردد غيرها، وصدّقت حين كذّب الناس، وبذلت مالها كله حين كان الإسلام في أمسّ الحاجة إلى من يحرسه بالاقتصاد قبل أن يحرسه بالسيوف. خسرت تجارتها، ومكانتها، ورفاهيتها، لكنها ربحت الخلود في ضمير الدعوة.
وُلدت السيدة خديجة  قبل البعثة النبوية، في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي، وتزوّجت من النبي ﷺ قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وكان عمره الشريف خمسًا وعشرين سنة. وتوفيت السيدة خديجة
قبل البعثة النبوية، في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي، وتزوّجت من النبي ﷺ قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وكان عمره الشريف خمسًا وعشرين سنة. وتوفيت السيدة خديجة  في العاشر من شهر رمضان من السنة العاشرة للبعثة النبوية، في العام الذي عُرف بعام الحزن، ودُفنت في مكة المكرمة بمقبرة الحَجون «المعلاة».
في العاشر من شهر رمضان من السنة العاشرة للبعثة النبوية، في العام الذي عُرف بعام الحزن، ودُفنت في مكة المكرمة بمقبرة الحَجون «المعلاة».
وكان للنبي ﷺ من السيدة خديجة  ابنان هما القاسم وعبد الله، وقد تُوفّيا في سن الطفولة، وكانت ابنته الوحيدة التي امتدّ منها نسل النبي ﷺ هي السيدة فاطمة الزهراء
ابنان هما القاسم وعبد الله، وقد تُوفّيا في سن الطفولة، وكانت ابنته الوحيدة التي امتدّ منها نسل النبي ﷺ هي السيدة فاطمة الزهراء  ، التي حملت امتداد الرسالة في ذريتها الطاهرة.
، التي حملت امتداد الرسالة في ذريتها الطاهرة.
وقد فسّر جمع من علماء التفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾
بأن من مصاديقه الكبرى امتداد نسل النبي ﷺ عبر السيدة فاطمة الزهراء  ، بعدما انقطع نسل الذكور بوفاة القاسم وعبد الله، فكان الكوثر نسلًا باقيًا ممتدًا في الزمان، يحمل نور الرسالة عبر ذريتها الطاهرة.
، بعدما انقطع نسل الذكور بوفاة القاسم وعبد الله، فكان الكوثر نسلًا باقيًا ممتدًا في الزمان، يحمل نور الرسالة عبر ذريتها الطاهرة.
عاشت السيدة خديجة  مع النبي ﷺ حصار الجوع في شعب أبي طالب، وتقاسمت معه قسوة الأيام، ولم تكتب يومًا شكوى، ولم تُسجَّل عليها لحظة تراجع. رحلت قبل أن ترى رايات الإسلام تملأ الآفاق، لكنها كانت هي التي غرست أول جذوره في أرضٍ كانت قاحلة بالخوف والإنكار.
مع النبي ﷺ حصار الجوع في شعب أبي طالب، وتقاسمت معه قسوة الأيام، ولم تكتب يومًا شكوى، ولم تُسجَّل عليها لحظة تراجع. رحلت قبل أن ترى رايات الإسلام تملأ الآفاق، لكنها كانت هي التي غرست أول جذوره في أرضٍ كانت قاحلة بالخوف والإنكار.
ويكفيها شرفًا أن النبي ﷺ لم يتزوج عليها وهي على قيد الحياة، وبقي بعدها يذكرها بوفاءٍ لا يعرف النسيان، ويستعيد حضورها في تفاصيله، ويرسل الهدايا إلى صديقاتها، وكأن السيدة خديجة  لم ترحل يومًا عن قلبه.
لم ترحل يومًا عن قلبه.
ومع كل هذا، بقيت سيرة السيدة خديجة  حاضرة في الكتب أكثر مما هي حاضرة في الوعي العام. تُروى سيرتها، لكنها لا تتحول دائمًا إلى مشروع وعي، ولا إلى نموذج حيّ يُستحضَر في التربية، وفي الخطاب، وفي تشكيل صورة المرأة الصانعة للتاريخ. فالسيدة خديجة
حاضرة في الكتب أكثر مما هي حاضرة في الوعي العام. تُروى سيرتها، لكنها لا تتحول دائمًا إلى مشروع وعي، ولا إلى نموذج حيّ يُستحضَر في التربية، وفي الخطاب، وفي تشكيل صورة المرأة الصانعة للتاريخ. فالسيدة خديجة  ليست صفحة في كتاب، ولا ذكرى عابرة، بل أصل في التأسيس، ومعنى ممتد في وجدان الرسالة.
ليست صفحة في كتاب، ولا ذكرى عابرة، بل أصل في التأسيس، ومعنى ممتد في وجدان الرسالة.
ليس المطلوب منّا أن نذكر السيدة خديجة  بالبكاء على عظمتها فحسب، بل أن نحوّل سيرتها إلى وعيٍ حيّ، وإلى ثقافة تُغرس في النفوس منذ الصغر. أن تتحول خديجة من اسمٍ يُستعاد في المناسبات، إلى نموذجٍ يُستحضَر في البيوت، وفي المدارس، وفي منابر الوعي، وفي خطاب المرأة والرجل معًا.
بالبكاء على عظمتها فحسب، بل أن نحوّل سيرتها إلى وعيٍ حيّ، وإلى ثقافة تُغرس في النفوس منذ الصغر. أن تتحول خديجة من اسمٍ يُستعاد في المناسبات، إلى نموذجٍ يُستحضَر في البيوت، وفي المدارس، وفي منابر الوعي، وفي خطاب المرأة والرجل معًا.
نحتاج أن نحتفي بها بوصفها سيدة المبادرة، وسيدة الثبات، وسيدة الشراكة في صناعة الرسالة، لا بوصفها زوجة نبي عظيمة فقط، بل بوصفها عقلًا وقلبًا ومالًا وموقفًا أسهمت في تغيير مجرى التاريخ. لقد كانت مشروع أمة في لحظة تأسيس، وكانت وعيًا سابقًا لزمانه، وإيمانًا سبق الجماهير.
إن استحضار مواقفها في زمن الاضطراب، وفي زمن التردد، وفي زمن الحاجة إلى قدوات صادقة، هو حاجة تربوية قبل أن يكون واجبًا تاريخيًا. فالأمم لا تُبنى بالشعارات، بل تُبنى بنماذج تُزرع في الذاكرة، وتُستدعى في اللحظات المفصلية.
ومن هنا، فإن الاحتفاء الحقيقي بالسيدة خديجة  لا يكون في موسمٍ عابر، ولا في ذكرى تُطوى بانتهاء يومها، بل في إحياء روحها في مشاريعنا، وفي بيوتنا، وفي وعينا، وفي طريقة فهمنا للإيمان والبذل والشراكة والتضحية.
لا يكون في موسمٍ عابر، ولا في ذكرى تُطوى بانتهاء يومها، بل في إحياء روحها في مشاريعنا، وفي بيوتنا، وفي وعينا، وفي طريقة فهمنا للإيمان والبذل والشراكة والتضحية.
فهي ليست امرأة من الماضي… بل بوصلة للمستقبل.