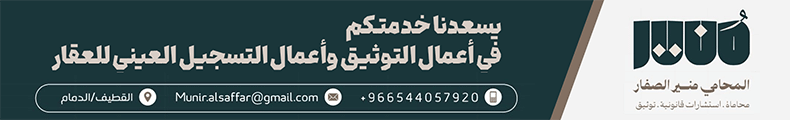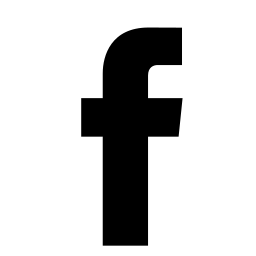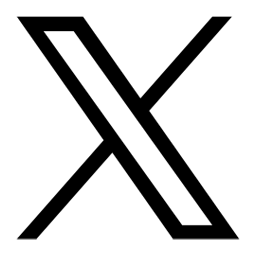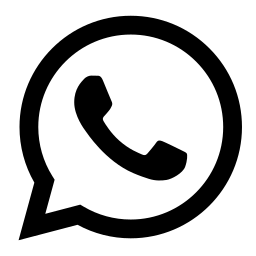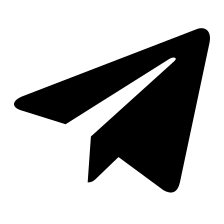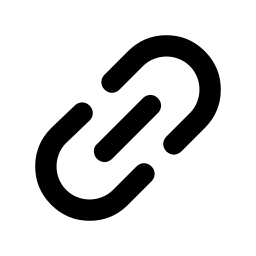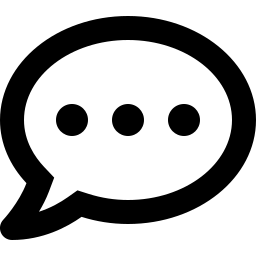وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا
ثلاثة أقراص من الخبز، قُدِّمت في ثلاثة أيام متتالية، خرجت من بطونٍ أنهكها الصيام وأخذ منها كل مأخذٍ، فذهبت إلى مسكين ويتيم وأسير. فكانت النتيجة آيةً كريمة خالدة، يتلوها المؤمنون آناء الليل وأطراف النهار ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [1] .
كثيرًا ما أقف عند هذه الآية بتأملات تناسب عقلي القاصر، غير أن لي أن أتأمل، متعجبًا، كيف يُخلّد القرآن الكريم أبسط الأعمال بميزانٍ لا يميل، ويمنحها وزنًا لا يُقاس بمقاييس البشر.
ترى...
ما وزن تلك الأقراص؟ وما مقدار الطحين الذي عُجنت به؟ بل ما قيمتها السوقية؟!
وكم نسخة من المصاحف—منذ لحظة نزولها حتى اليوم، وإلى قيام الساعة—حملت بين دفّتيها هذه الكلمات الخالدة؟
وكم مرة كُتبت، وتُرجمت، وتُلِيَت، وتداولها الناس في الورق، وفي الصوت، وعلى الشاشات، ومنصات التواصل؟
ومن يدري...
كيف ستتناقلها تقنيات المستقبل؟
هل تُبث في الهواء؟ تُنقش على الجلد؟ تُخزَّن في الضوء؟
وكم نفسًا تلتها وستتلوها من لحظة نزولها إلى قيام الساعة؟
أبالمليارات؟ بالتريليونات؟ أم بأعداد لا يُحيط بها إلا الله وحده؟
كل ذلك... لأجل ثلاثة أقراص!!.
لكنها لم تكن طعامًا فحسب، بل أقراصًا من نور، عجَنها الإخلاص، وسقتها يدُ الإيثار.
وكل ذلك يجرّنا إلى قوله تعالى ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [2] .
بل وفي سياق مشابه لذلك، ورد عن النبي الأعظم ﷺ «لَضَربةُ عليٍّ لعمرو يوم الخندق تعدِلُ عبادةَ الثقلين.» [3]
سبحان الله... مجرّد ضربة بسيف؟
تعدل عبادة الجن والإنس؟
فهل هذه المعادلة محصورة من غزوة الخندق إلى قيام القيامة؟
أم أنّ معناها مطلق، منذ خُلق آدم إلى آخر ساعة من الدنيا؟
وهل تشمل عبادة الثقلين أعمال الأنبياء جميعهم؟
أم أن لهم استثناءً خاصًا يفصلهم عن حساب الثقلين؟
أسئلة تبقى مشرعة للروح المتأملة ولسِرّ العدالة الإلهية التي لا تُقاس بميزان البشر.
وفي ضوء كل ما سبق، تتوهّج هذه الآية كنبراسٍ للنية الصادقة والعمل الخفي ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ .
لهذا، ينبغي لنا أن نتأمل في كل عملٍ نعمله، فرُبّ عملٍ نراه بسيطًا، وهو عند الله عظيم.
على سبيل المثال، لا على الحصر، شاهدتُ صدفةً عبر تطبيق ”تيك توك“ مقطعًا أثار دهشتي.. فتاة أمريكية من مدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية تُبدي إعجابها بلطميةٍ حسينية [4] أنشدها الرادود الأحسائي محمد بوجبارة [5] .
قالت إنها وقعت على المقطع بالصدفة، ولم تكن تعرف كيف تبحث عنه، فحاولت الوصول إليه من خلال اللحن حتى وجدته بصعوبة. والمدهش أنها ظنّت في البداية أنها مجرّد أغنية، لكنها حين قرأت ما كُتب في التعليقات، أدركت أن ما لامس وجدانها كان لطمية رثائية تُستذكر فيها شخصية إسلامية عظيمة، وقع عليها من الظلم والتنكيل ما تهتز له القلوب.
ومن حيث لا تدري، قادها هذا المقطع للقراءة عن كربلاء، وعن الطف، وعن الإمام الحسين  . [6]
. [6]
فهل كان الأمر عابرًا؟
أم أن لتلك اللطمية نصيبًا من قوله تعالى ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ ؟
فلعلّ ما نستهين به يدوِّي صداه في قلوب لم نسمعها، ويغدو عند الله عظيمًا.
في زمنٍ صار فيه كل شيء قابلًا للانتشار، ليس المطلوب أن يُشاهدك الملايين، بل أن يصل منك شيء، ولو خفيًا، إلى قلبٍ واحدٍ بصدق فاستحضر نيتك، ولا تحتقر أثرًا، رُبّ لطميةٍ سُمعت عابرًا... كانت باب هداية ورُبّ سهمٍ أنطلق من نية طيبة... أصاب موضعًا لا تصله آلاف الكلمات.
لذلك، باتت مسؤولية الرواديد اليوم أثقل حتى من مسؤولية خطباء المنبر الحسيني؛ إذ إن الطرح المنبري غالبًا ما يتراوح بين التأريخي، والفقهي، والعقائدي، والأخلاقي، ثم يُختتم بالرثاء، وهو بذلك موجّه إلى جمهورٍ خاصّ، محدود نسبيًا. أما الرادود، فإن صوته يخترق الحواجز، ويصل إلى الصغير قبل الكبير، المخالف [7] قبل الموالف، البعيد قبل القريب؛ فمنهم من تجذبه الكلمة الحماسية، ومنهم من تأسره النغمة الحزينة، ومنهم من يتأثر بكليهما.
ومن هنا، فإن الآية الكريمة ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ قد تكون محمولةً على وجهين: إما الثواب الجزيل الذي يُمنح للعمل الصادق، أو المسؤولية العظمى التي تترتّب على أثرٍ سلبيٍّ لا قدّر الله، إن خرج الصوت عن مساره، أو انحرف عن غايته الرسالية إلى غايةٍ شكلية أو استفزازية... والحرُّ تكفيه الإشارة..