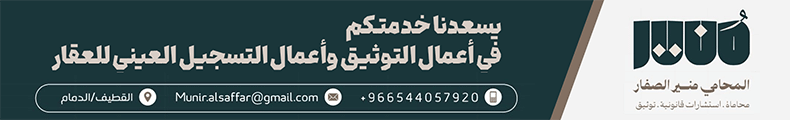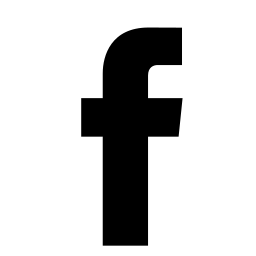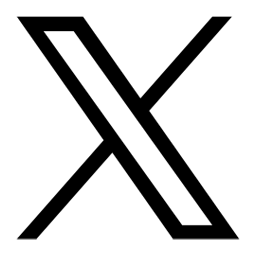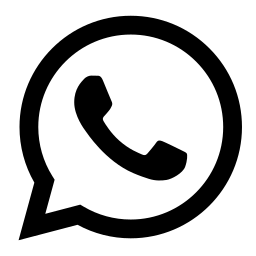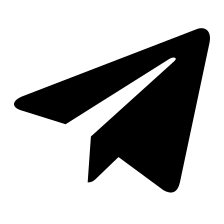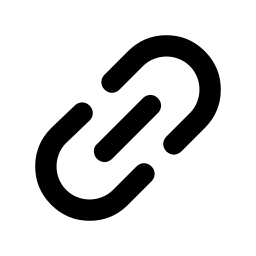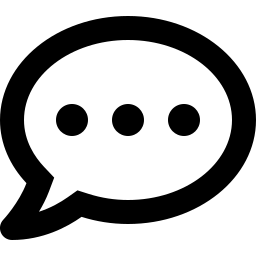وشمُ خَولة.. الانعكاس والمكافئُ الموضوعي في قصيدة ”وقفة على أطلال خولة“ للشاعر عدنان العوامي
للمكَان حضُور لافت في القصيدة، حيث تستعيدُ التاريخ القديم والقريب، كما تتطلَّع إلى المستقبل الآتي والبعيد، بتغيُّراته الكثيرة والمثيرة، بينما يتقدَّم ويتطور ويحمل العديد من المفاجآت؛ لأنَّ التاريخ جدلٌ مستمر بين زمنين، أحدهما انقضَى، والآخر ما زال في طور التشكُّل، لهذا لن يكون غريباً أن يلجأ إليه الشَّاعر؛ ليُسقط عليه رؤاه الإنسانيَّة والحضارية، وهو ما جعل المتلقِّي يدرك ارتباط الشَّاعر بالأرض، وما تُمثِّل له من امتداد وإرث تاريخي وثقافي، يصلُ حاضره بماضيه ومستقبلِه.
الحاضرُ والماضي؛ جدليةٌ تقاربها القصيدة، وتعتمدُ عليها في التشكُّل والتكوُّن، فالماضي ركيزةٌ أساسية، ولبنة لا بد منها؛ لرؤيةِ المستقبل، وإشادته كَما ينبغي، وهو ما قامَ به الشاعر، معتمداً على التقاطع بينَ قصيدته «وقفة على أطلال خولة»، ومعلَّقة طرَفة بن العبد، التي يجوز أن يُطلق عليها «وشم خولة»؛ بسبب كثرة تداولِ البيت الأول منها، والاستشهادِ به على الزينة النسائيَّة في العصر الجاهِلي.
”خولة“ قاسمٌ مشترك بين القصيدتين، تسِير بهما من البدايةِ إلى النهاية، مع اختلافات تفصيليَّة من ناحية أدائِهما واختياراتهما، في الصُّورة واللفظ والعِبارة والتوظيف، وهو اختلافٌ طبيعي؛ نظراً لبعد زمن الكتابة بينَ القصيدتين، ووقوع الشَّاعرين وتأثرهما بظروف حياتيَّة متفاوتة.
معلَّقة طرَفة تبحث عن تعليل لتصرُّفاته وعلاقتها بتغيُّرات الزمان، بينما تبحثُ قصيدة العوامي في تغيُّرات الزمان وتقلُّبات الأحوال بالنسبة للمكَان؛ حيث الأولى تنظرُ إلى الذات وعلاقتها بالمحِيط، بينما الثانية تنظرُ إلى المحِيط وعلاقته بالذات والتَّاريخ والثقافة، فالبوصلة بينهما تختلفُ في الاتجاه، إذ حينما يميل طرَفة إلى تركيز موضُوع القصيدة حوله، جاعلاً من نفسه محور الاهتِمَام ومركز الكون، يُعاكس العوامي هذه النظرة؛ ليركِّز اهتمامه على مدينته «القَلعة»، وما لحقها من تغيُّرات وتبدُّلات، فيجعلُها محور اهتمامه، ومركز قصِيدته، وهذا فارقٌ جوهري؛ سيؤدِّي إلى طرح تساؤل حولَ طريقة بنائه لقصيدته، وكيفَ اختلفت عن معلَّقة طرَفة!
بدأت معلَّقة طرَفة بالبيت التالي: ”لخولةَ أطلالٌ ببرقة ثهمَد تلوحُ كباقي الوشمِ في ظاهرِ اليد“، وهي البداية نفسُها التي بدأ بها العوامي؛ حيثُ يقول: ”سلاماً سلاماً منازل خوله سلامَ الخليل تذكَّر خِلَّه“، فرغم تشابُه البدايات؛ إلا أنَّ الاختلاف يقع بعدهما مُباشرة، إذ طرَفة يقطع قصيدته عن التَّواصُل مع خولة، ويتجه إلى أصحابه الذين استدعَاهم؛ ليعينوه على بُكائه وحزنه، أثناء وقوفه على أطلالها: ”وقوفاً بها صحبي عليَّ مطِيُّهم يقولون لا تهلِك أسىً وتجلَّد“، وهو ما سينتقلُ بقصيدته من اتجاهها الغزلي إلى موضُوع التظلم والتبرُّم من جور الحياة، فالمكانُ بالنسبة إليه ليسَ أكثر من انتقال بالقصِيدة من موضوع إلى موضوع، ومن معنى إلى معنى، لتكُون ”خوله“ ضحيَّة هذا الانتقال، وأكثر من تأثَّر به؛ لأنها اختفَت وتوارت عن الحضُور؛ بسبب تعدُّد المعاني وكثرتها.
كيفيَّة بناء القصِيدة الجاهلية، لا تمنحُ الشاعر فُسحة التغيير والتبديل، وهو ما حصل مع طرَفة، الذي التزمَ بمواضيعها، وطريقة بنائها، ولم يخرُج عن العمود الشِّعري كما كان متداولاً، وهذا ما تحرَّر منه العوامي، الذي انتقل بالقصِيدة من إطارها العمُومي إلى الخصوصية الذاتية، فاستطاعَ بذلك أن يُعطيها دَفقة عالية من الاندفاع العاطِفي، الممزُوج بالهمِّ الحضاري، لمدينة حدثَت فيها الكثير من التغيُّرات، حتى تبدَّلت ملامحها، وتغيَّر وجهها، وغدت مُختلفة عن السابق، فما كان مألوفاً انتهى، وما كان متعارفاً عليه زال، وما تعوَّد عليه أبناؤها لم يعُد له وجود، الأمرُ الذي نقل مُقاربة القصيدة إلى مستوىً آخر؛ تمثَّل في بحث انعكاس التغيُّرات الحضارية والاجتماعية والثقافية، وتأثِيراتها على الشَّاعر وشعره.
نظريةُ الانعكاس؛ نظرية اجتماعيَّة تبحث في التغيُّرات التي تحصل داخلَ المجتمعات، من حيث هي أسبابٌ تؤدي إلى نتائج، تتَّخذ صفة الاتجاهات والمدارس، وهو ما استلهمه الأدَب، وأخذ به، ثم طبَّقه على الاتجاهات التي نشأت، والمدارس التي ظهرت، فظاهرةُ الفقر الشديد؛ أدَّت إلى بروز اتجاه شعري رفعَ من شأن الزهد، وظاهرةُ المجون والخلاعة؛ أدَّت إلى بروز غرَض شعري، تمثَّل بالغزل المذكر، أو غزلِ الغلمان، وظاهرةُ التأثر بكتاباتِ الشعراء والأدباءِ الغربيين في بدايات القرن العشرين؛ أدَّت إلى ظهور تيَّارات فكرية، ومدارس أدبيَّة على رأسها الديوان وأبولو، فهذه الاتجاهاتُ والمدارس إنما هي نتائج لتأثِيرات حضارية واجتماعية وإنسانية؛ أثَّرت وأثْرت الساحة الأدبية بالكثير من التحولات العمِيقة، التي لا زالت باقية، رُغم زوال سبب نشأتها، وابتعاده زمنيًّا.
قصيدةُ العوامي ابتدأَت بالغزلِ العفيف، فتشابهت مع معلَّقة طرَفة في تذكُّرها للمكانِ وساكنيه؛ إلا أنها اختلفَت عنها في انقطاعها اللاحقِ عن المكان، مؤسِّسة شبكة جدِيدة من العلاقات، غدَت فيها ”خوله“ المحورَ الرئيس، مع بقاء أهميَّة المكان، إذ سيصبحُ موضوعاً تابعاً، وغيرَ مستقل، من وجهة نظرِ القارئ، الذي سيربطُ بينها وبين بقايا الأبنية، الشَّاهدة على العمقِ الحضاري والتاريخي للقلعة، فيقولُ بعد الافتتاح والسلام على منازلِ خولة:
"تذكَّر مدرج أحبابه ضفافاً ومشتلَ ضوءٍ ونخله
وملهى صباً سوسنيَّ الأديم تطوفُ المواسم بالعشقِ حوله
تذكَّر سيفاً ورفَّة قلعٍ ونجمة صيفٍ تُغازل تلَّه
وداليةً تستضيفُ المساء سراجاً وكوخاً، ومهداً وكِلَّه
وتحتضنُ الصبح شمساً وهمساً وظلًّا وطلًّا وتيناً وسلَّه
وجدول ماسٍ يُسبسِب عشقاً ويُنضج شوقاً ويُخصب رمله"
الملهى السَّوسني، الذي تطوفُ المواسم بالعشق حوله، ليسَ إلا مكان خولة، يتردَّد بين جنبات قصيدته، فلا يُفارقها إلا ليعودَ إليها، وهذا هو الحوارُ الإضافي والمختلفُ عن حِوارية طرَفة مع مكانه وأرضه، التي تشتركُ مع أرض الشاعر، وتتشابهُ معها في التضاريسِ والموقع والعمقِ التاريخي، إذ هما أرضٌ واحدة، لكنْ بزمانين مختلفين متباعدين، الفارقُ بينهما يتجاوز ألفَ عام، وهي مدة تؤدِّي إلى حدوث تغيُّرات، وإزالة معالم، واستحداثِ أخرى، فللزمن أحكامه، والتطوُّر أحدها، لكنَّ ما لا يتغيَّر هو الإنسان، وهذا ما حاول الشَّاعر الاتكاء عليه، فجعلَ قصيدته نابضةً بالحب والحيوية، متخذاً نهجاً رومانسيًّا في مقاربة حبيبته؛ حيثُ أخذ يعود إليها كلما انتهى من تذكُّر أرضه، وما حدث فيها من تغيُّرات متلاحقة وسريعة؛ ما جعله يحنُّ لماضيها ولتاريخها السَّابق:
"سلام ٌ عليكِ سلام الحبيبِ سلام الغريبِ تعشَّق أهله
سلام المهاجرِ أدمى خطاهُ هجيرٌ ووحشة دربٍ ورحلة
فعادَ إليك نزيفُ الجراح تكادُ دماه تخضِّب رجله
على جفنه رِعشة من سَناك وفي شفتيه اختلاجة قُبله
وفي ثوبهِ من بقايا ثراك بَهارٌ، ونورٌ وعشبٌ وظِلَّه
ومن لفحِ شمسك في عارضِيه يرفرفُ نجم وتضحك فلَّه
ومن وهَج من هواكِ القديم بقيَّة غارٍ تجلِّل رَحله"
ها هو يصلُ لحظة الوصل بين الحبيبةِ والمكان، فيجعلهما واحداً، فما تدلُّ عليه الحبيبة يدلُّ عليه المكان، وما يدلُّ عليه المكان تدلُّ عليه الحبيبة، وهذا الامتزاجُ والتماهي بين المدلولات رغم تعدُّد الدوال؛ يشيرُ إلى استعماله «القناع» في بناءِ قصيدته، وهي تِقنية تهدف إلى إخفاءِ وجهه الحقيقي؛ كي يتمكَّن من المشاركة في القصِيدة ودفعِ عاطفتها إلى الأمام، عبر إظهار وجهٍ آخر؛ يكون رمزيًّا وغير حقيقي، لكنَّ الذي حصلَ عكس ذلك، فلم يعد الهدفُ إخفاء وجهٍ وإظهار آخر، بل أصبحَ إظهار الوجهين معاً؛ وجه المكان ووجه الحبيبة والمشاعر المتعلِّقة بها:
"أتاكِ يفتِّش خلف الركام عن الأمس داراً وجاراً وخِلَّه
عن امرأةٍ من أعزِّ النساء جلالاً ورفعة قدرٍ ونِحله
ومن أجملِ الفاتنات الملاح قواماً وجيداً وثغراً ومُقله
ومن أكرمِ الغيد حين العَطاء إذا الحال يسرٌ أو الحال قِلَّه"
رغم تأثُّر الشاعر بمعطيات عصره، والاتجاهات الشِّعرية الناشئة عن الرومانسية، والمتَّخذة لكثير من مبادئها أساساً في الكتابة والتصوير، إلا أنه حافظَ على كلاسيكيته، التي تُعلي من المُثل العليا في صورة المرأة، فلم يُقاربها كحبيبة قريبة يبثُّها لواعجَه وأشواقَه الحارة، وإنما بثَّ لقناعها حنينه وشوقه للمدينةِ الآخذة بالتغيُّر والتبدُّل، بأبنيتها ومعالمها وأشخاصِها، وهو ما سبق وأسَّس له عبر استخدامه لتِقنية القناع، فأخفى وجهَ حبيبته وأظهر المدينة، وجعلها محورَ الاهتمام.
الكلاسيكيةُ الجديدة، أو الكلاسيكية الممزوجةُ بالرومانسية؛ تيارٌ شعري نما ولا يزال منذُ بدايات القرن العشرين، حينما توثَّقت العلاقات الأدبية العربيَّة مع الآداب الغربيَّة المترجمة، فحظي بكثيرٍ من الاهتمام، وتمَّ الاتجاه إليه؛ لمزجِه بين القِيَم الكلاسيكية، والألمِ الداخلي؛ المتمثِّل بموضوعات «الفقد والحنين»، وهو ما يُمكن رؤيته بوضُوح في قصيدة «وقفة على أطلال خولة»، التي جمعَت الحنين إلى الوطنِ والحنين إلى الحبيبة، والألمَ لما أصاب الوطن من تغيُّرات، والألمَ للبعد عن الحبيبة وتغيُّرها.
تغيُّرات كبرى مرَّت بها القصيدة، وهي تسيرُ عبر جدليَّة ”الحبيبة / الوطن“، حيث الحبيبةُ والوطن؛ هما المكافئُ الموضوعي للشَّاعر، إذ كلما حصل تغيُّر في الخارج؛ انعكسَ على داخله، وأثَّر فيه، فالهدمُ في الأبنية، والأحراش، وغاباتِ النخيل، والمرفأ؛ يقابله ألمٌ شديدٌ انعكس على الكتابة، وظهرَ في هيئة حنينٍ للحبيبة، واستعادة صُورتها المثالية في الذهن؛ حيث كلُّ حركة داخل القصيدةِ تقابلها حركةٌ موازية، تمتلكُ نفس الدَّرجة من التوتر والانفعال.
هذه هي الحواريةُ التي تطرحها القصِيدة، وتعتمدُ عليها في بنائها، مستخدمة المكافئ الموضوعي؛ الذي يشيرُ إلى التأثير المتبادلِ بين الكاتبِ والكتابة؛ حيث زيادة حُزنه على هدم معالمِ بلده؛ ستؤدِّي إلى زيادة تمسُّكه بحبيبته، وإفساحِ المجال لها للظهور بصُورة أكبر، وتمجِيد أفعالها وكلماتها:
"على بابها تستريحُ القوافل من كلِّ حدبٍ ومن كلِّ مِلَّه
وفي بيتها تتقرَّى الضُّيُوف تؤمُّ نداهُ وتنشدُ نُبله
وتسكنُ قصراً منيع الجَناب بضوءِ المآذن يغسلُ ظِلَّه
وبوحُ الكتاتيبِ يُثري ضُحاهُ ووحيُ المنابر يؤنسُ لَيله
وتملكُ نخلاً كنخل العِراق سخاءً وماءً زُلالاً كدجله"
يتوحَّد الدال في إشارته للمدلول؛ حيثُ المعنى واحد، رغم تعدُّد الدوال، فالمدينة والحبيبة وجهان لعُملة واحدة، تشير إلى التغيُّرات الكبرى في حياة الشَّاعر، التي غدت محورَ الاهتمام، وأبرزَ ما في القصيدة، إذ أجاد ببراعةٍ المزج بين الدَّوال؛ ولم يُشعر المتلقي بالانتقال بينها، ما منحَه فُسحة من الحرية؛ مكَّنته من التوسُّع في البوح، ليصبح أكثرَ حميميَّة وخصوصية؛ لأنه أمِن من انحرافِ فكر المتلقي، عن الدِّلالة التي رغب بإيصالها:
"هوَى القصرَ والعشق والذكريات وعفَّى الزَّمان مفاتن خَوله
سوى طللٍ من رمادِ السنين جفاهُ الأنيسُ وأنكرَ فضلَه"
”مفاتن خوله“ التي عفَّى الزمان آثارها، إنما هي مفاتنُ القلعة، بأبنيتها، وحدائقها، ومآذنها، وكتاتيبها، وقصورها، إذ زوالُ المفاتن يشير إلى فُقدان الاهتمام، فهي حوارية جدليَّة طرحتها القصِيدة، حينما استدعَت عنترة العبسِي؛ الفارس البطل، الذي رَغِب في الاستيلاء عليها، لكنَّه فشل، وعاد خائباً؛ بسبب دفاعِ أهلها، وحمايتهم لها من السُّقوط؛ حيث أرادَت من طرحها؛ تأكيد الصُّورة الرومانسيةِ للمدينة، وهي صورةُ المعشوقة الفاتنة، التي يتقاتلُ من أجل الظَّفر بها أقوى المقاتلِين:
"فعنترة تاه يوماً عليها غروراً وزهواً وجرَّر ذيله
وجاء مُدلًّا بسُلطانه يجرُّ الكتائب تتبعُ خيله
يهزُّ سناناً، ويرهفُ سيفاً ويُرعف رمحاً ويَرشق نبله
ولكنَّها ألقمته التراب وأردَته قزماً يلملمُ ذِلَّه"
تستقيمُ الصورة التي يرسمها الشَّاعر، مع الصورة الكلاسيكيةِ للحبيبة والمدينة، على حدٍّ سواء؛ حيث المدينةُ يدافع عنها أهلها، ويمنعون سُقوطها بيد الأعداء، وكذلك الحبيبة تُحمى وتُفتدى بالروح؛ لئلا تسقُط أسيرة بيدِ العدو، وهو ما يؤكِّد الاتجاه الكلاسيكي الجديد، أو الكلاسيكيةِ الممزوجةِ بالرومانسية، الذي ينتهجُه الشاعر ويسيرُ عليه:
”فداءً لعينيك ما في يديَّ وردءًا لعمرك عمريَ كُلَّه“
ثمة تحوُّل وتبدُّل أصاب الصورة الكلاسيكية للمدينة، إذ تغيَّرت بمرور الزمن؛ لهذا أضحت القلوبُ لا تميل ناحيتها، لأن التغيُّرات الكبرى، التي لحقتها، وتسبَّبت بإزالة مفاتنها؛ لم تكتفِ بإزاحة العاشقين والمحبين، بل أبدلَت مشاعرهم، وصيَّرتهم أقرب إلى التبلُّد وعدم الاهتمام، وصولاً إلى البراءةِ منها:
"فيبرأُ منك أحبُّ ذويك كأنك ذنبٌ. كأنك زَلَّه
كأنك ما كُنت للمدنِفينَ غراماً ومرفأ عشقٍ وقِبله"
رغم الصُّورة التي أصابها الضرر، وانتقالها من الجانبِ الإيجابي إلى السَّلبي؛ بتأثيرات الزمان وتغيُّر الأحوال، إلا أن الذات ستبقى وفيَّة لعشقها، ولن تتنازلّ عنه، وهنا تتجلَّى أبرز خصائص الكلاسيكيةِ والرومانسيةِ معاً، فهما لا يتركان الحبيبَة، ولا يبتعدان عنها، ولا تتغيَّر مشاعرهما؛ مهما تغيَّر الزمان، وتقلَّب الحال، وهي الخاتمةُ التي يختم بها الشَّاعر قصيدته؛ إذ يؤكِّد أنه سيظل العاشقُ الأول والأوفى، لكلٍّ من الحبيبة والمدينة:
"فلا تعتبِي يا هوايَ المقيمَ وإن عُدت نسياً فللمال جوله
وحسبك أن تسكُني مقلتيَّ ظِلالاً وخُصلة ضوء وكُحله
ويلهو ثراكِ على منكبَيَّ نِثارة عُرس وفرحة طِفله
فأضفِر منه لرأسيَ تاجاً وأغزلُ منه لجسميَ حُلَّه
وما بيدي أن يضنَّ البنونُ بقطرةِ دمعٍ تبلل رمله"