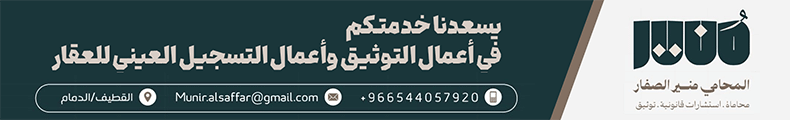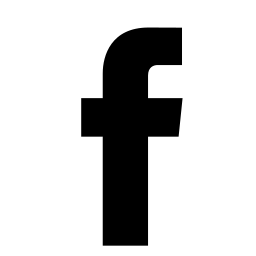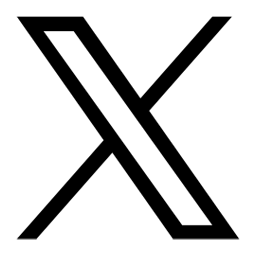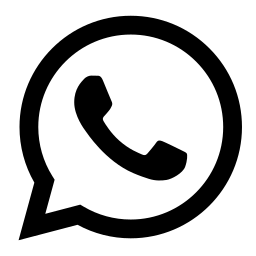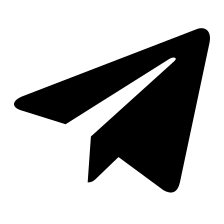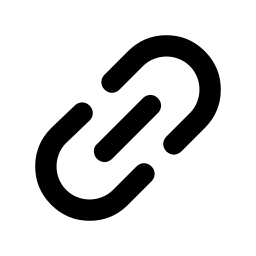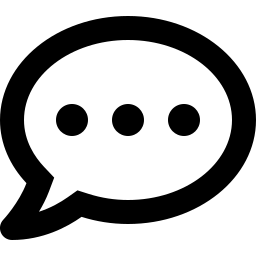مثل الذين ينفقون أموالهم
الطبيعة البشرية وما تحويه من مشاعر فطرية تعبر عن البساطة في الأفعال والتصرفات لا الاكتساب، هل تتوافق مع مبدأ العطاء والتفاعل الوجداني مع حالات الوجع والفقر والبؤس من حولنا أم أن غريزة حب الذات يتوافق معها الحفاظ على المصالح والمنافع الخاصة دون الالتفات لما تكون عليه حالة الآخرين المؤلمة، فهذا شأنهم الخاص وعليهم التوافق والانسجام معه؟
الحديث عن مبدأ العطاء تارة يتم تناوله من منطلق إسلامي يؤكد على حقيقة الوجود الأخروي بعد الموت، وبالتالي فإنه يصور العطاء على شكل تكوين الرصيد الأخروي النافع في يوم الحساب وما يرفع كفة الحسنات في ميزان الأعمال في محكمة العدالة الإلهية، وهذا الدافع «الثواب الكبير» يشجع المرء على البذل وبلسمة آلام المحتاجين بشيء بسيط مما ينعم به عليه رب العالمين، فالإنفاق لا يكون منافسا أو سابقا لتوفير مستلزمات الحياة الكرية لنفسه ولأسرته، وإنما هو بذل مما زاد من المؤونة يمسح به على رأس اليتيم ومن أقعده عن الكسب المرض والعجز، وهذا ما نطلق عليه مسمى التكافل الاجتماعي أي تقديم شيء من العطاء من المقتدر ومن فاض شيء من احتياجه للطرف الضعيف، بما يوازن الحالة المالية لأفراد المجتمع فيحفظ كرامة وماء وجه المحتاج ويبعث بمشاعر السعادة والراحة النفسية للباذل، وبذلك ترفع نظرة الحرمان والشعور بالنقص من نفس المحتاج وتعيده على سكة العمل المنتج والمثابر في حركة عجلة التنمية والازدهار المجتمعي، وهذه المعالجة القرآنية لمسألة الاعتياز ومقاربتها من منظور الواقعية، يبدد مشاعر الحقد والكراهية من النفوس ويرسم معالم الأمن الاجتماعي، حيث يشعر المرء بأنه ليس لوحده في مواجهة المصاعب والأزمات المالية ما دام هناك من حوله أصحاب القلوب النقية.
الوصول إلى الضعفاء والمحتاجين وتخفيف وطأة الحاجة عنهم تعد من أقرب الطرق إلى ساحة الرحمة الإلهية والاستظلال بها يوم القيامة، فالرحمة بالمحتاجين شعاع من التخلق بأخلاق الله تعالى وصفاته الجمالية المتمثلة بسعة رحمته ولطفه وإسباغه النعم على عباده، ويد العطاء التي تتحرك وفق تصور يخامر العقل بأن تنشيف دمعة اليتيم ومسح سحنة الحزن والألم من وجه الفقير ما هي إلا من تجليات الفيض الرباني على مخلوقاته وعباده في جميع جوانب حركتهم الجوهرية، نعم هي السعادة الحقيقية بإثبات الوجود بالفاعلية المجتمعية وإحداث أثر إيجابي - مهما كان حجمه - في رسم الابتسامة على الوجوه البائسة وتفريج همهم.
وأما شح النفس والأنانية والانطلاق في التصورات المتعددة لما حوله من خلال ذاته وذاته فقط فهو بالتأكيد مرض نفسي قبل أن يكون آفة أخلاقية، ولننظر لحال ذلك البخيل المتصور بأن له القدرة على جمع وكنز ماله وتنميته مع إشراقة كل يوم جديد، هل نجده يسلم من الهواجس والقلق القاتل من المستقبل وما يواجهه من صعوبات مالية قد تسلبه ما أفنى عمره وبذل أوقاته من أجله؟
وكفى بالقلق مؤرقا وسالبا لنعمة قد يظفر بها الفقير ويحرم منها ذلك البخيل وهي راحة البال والهدوء النفسي، إذ إن الاعتقاد بأن القدرة البشرية هي الحافظة والحارسة لثروته هو محض الوهم والخيال، وذلك أن الهزات والأزمات المالية ليس ببعيد عنها أي واحد منا، وقد يفقد جزءا من ماله أو أكثر، وهذا يؤدي إلى حالة الانهيار والإصابة بالكآبة والحزن المخيم عليه ويدوم أسفه واجتراره لآلامه وخسارته والكارثة التي ألمت به، بينما النظرة الإيمانية تنبثق من فكرة أن القدرة المطلقة والقوة المحركة للكون وما فيه لرب العالمين، وبالتالي فإن الإصابة بالضر والخسارة المالية لا تعني نهاية العالم والأسف المزمن لن يغير الواقع، وبالتالي فإن المحرك للنفس وهو الأمل بالله تعالى والنظرة الإيجابية لن تغادر نفسه وسيعمل جاهدا على تغيير المستقبل بما يتوافق مع قدراته وإمكانياته، فالقناعة تعد صمام الأمان لأنفسنا من تسلل الآفات لها فهي تعني العمل الجاد والمثابر بلا كلل نحو تحقيق آماله وتطلعاته ومواجهة الصعاب والتحديات دون يأس مهما صادف من عراقيل وعثرات.