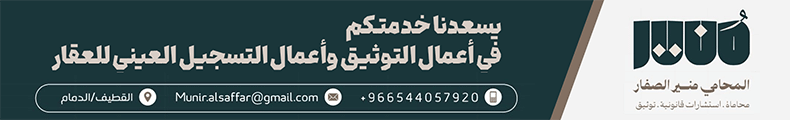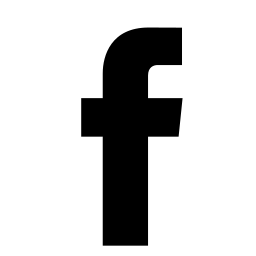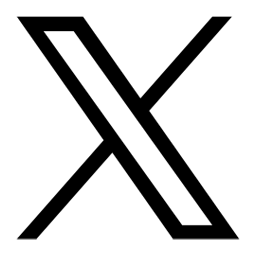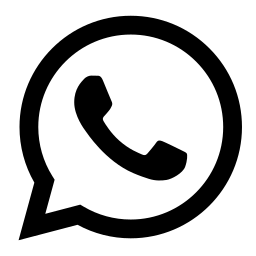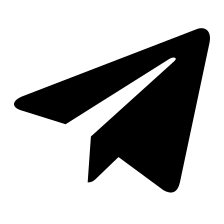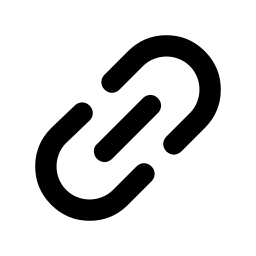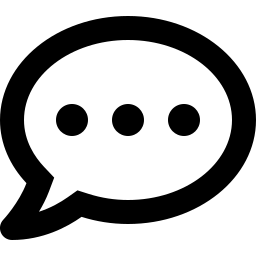الكينونة المنسية في اشتغالات ميلان كونديرا
هذا التعبير الهيدجري الساحر، يكتنز في أعماقه رحلة الإنسان النفسية والروحية برمتها دون أن يغادر منها حرفا واحداً.
وهو تعبير قد إلتقطه العبقري ميلان كونديرا، وأعاد نفخ الروح فيه من خلال ”ثيربانتس“ وذلك عبر مقالٍ تأملي بعنوان ”إرث ثيربانتس المحتقر“ والذي حرره في كتابه التأملي ”فن الرواية“.
لا يمكننا أن نفهم هذه الكينونة المنسية، ولا أن نفهم ذلك الإرث المحتقر، إلا إن قمنا برحلة تمهيدية، تنطلق من ”ثيربانتس“ في روايته الفروسية العظيمة ”الدون كيخوته“ لكي نعبر من خلالها إلى ما يعنيه كونديرا بتحقير هذا الإرث العظيم، وهذا ما سيتيح لنا تحقيق وعي صارمٍ وفهمٍ عميقٍ، لما قاله مارتن هيدجر في كلمتين فقط.
تعتبر رواية الدون كيخوته أو كيشوت - كلا التعبيرين صحيح والفارق في طريقة التقعر والتشدق إن كانت إسبانية إم فرنسية - من أدب الفروسية ولن نعرف كيف أصبحت هذه الرواية وهي إرث ثيربانتس محتقرة إلا بتلمس ما أحدثه ”ثيربانتس“ من فارق جوهري في أدب الفروسية حتى صار لدينا أدب فروسية قبل وبعد ثيربانتس بل قل صار لدينا أدب ما قبل وما بعد ثيربانتس بصورة عامة.
ونحن لو تفحصنا كما تفحص ثيربانتس جميع شواغل أدب الفروسية سنجد أنها وبرمتها منسوجة من بنات المخيلة الصرفة والتي لا تمت للواقع بصلة، فهي بمجملها تنطلق من منطقة الحُلم الأسطوري، وقصص المغامرات، والتي تحمل أهدافاً محددة، وهي اهداف تنتشر في كل ألوان هذا الأدب المهزوم، ولعلنا نتلمسها في قصنا الشعبي، ممثلاً في السيرة الهلالية، أو سيرة عنترة، أو حتى في حدود الصورة الشعبية لسيرة الإمام علي  .
.
هذا كله في أدب فروسية ما قبل ثيربانتس، وأما ما بعد ثيربانتس فمختلف جدا، حيث أحدث هذا الروائي الانعطافة الكبرى في أدب الفروسية؛ عندما عبر به من أودية المتخيل الأسطوري المحاكي للحظة أحلام المجتمع المقهور الذي يرسم انتصاره في وديان الخيالات المتخفية ليبلغ بها جبال النقد وقممه كنوع من تمثل للمعيش اليومي، بنحو يصل الحاضر بالماضي سردياً لكنه يقطع بينهما في أرض الإنجاز والواقع ليبشر براهن وحاضر نقدي عوض الاحتباس في الوهم ورسم الانتصارات المتخيلة بترسيم الشخصيات البطولية والنفخ فيها بصورة مبالغة تتجاوز حدود المعاش بل ربما تجاوزت حدود الواقع المعقول وقد أجاد ثيربانتس الاختيار حين سكن في ذات الإنتاج السائد وذلك من خلال امتطائهً أدب الفروسة كمعبر ومنفذ لفن الرواية الخالدة، وذلك انه قدم لنا تهكميته اللاذعة، وسخريته المرة، عبر أدب الفروسية الموغل في التراث، وفي أودية المتخيل، ليبلغ به ذراري النقد، فينال من البلديات، والأديرة، وكل الأنظمة المزيفة، فيهاجم محاكم التفتيش، وكل ما هو مزيف، كالشجاعة المزعومة، والحكمة المدعاة، والتقوى المزخرف، ويهاجم الجماعات الأدبية، وما فيها من شعراء وروائيين من ذوي المواهب الرديئة أو انصاف الموهوبين، ويهاجم النقابات، ورجال الدين، والقضاة، والنبلاء.
هذا النقد كله صاغه عبر طريقته التهكمية الساخرة، وهو لم يجد وسيلة أنجع ولا أفضل منها ليعبر من خلالها لكل هذا الطيف الواسع من البذاءة، والرداءة، وانعدام الذوق، فكانت كل خرجة من خرجات هذا الفارس تنتهي بنقد لتلك الثقافة الواهمة المبتذلة في عصره.
والآن لعل أطراف الخيط قد بدأت تتضح وتقع بين يديك؛ لأن ثيربانتس الروائي قد رسم صورة الفارس النبيل دون كيخوته بكل سخرية لكي يعرفنا إنسان عصره.
لكن ما لم نفهمه حتى اللحظة هو عنوان كونديرا ”إرث ثيربانتس المحتقر“ فماذا يريد أن يقول هذا العجوز في تأمله هذا؟
دعنا نخوض أكثر مع ثيربانتس ليكون عبورنا إلى ميلان كونديرا أكثر سلاسة.
لن نتكلم عن النقد بلغة نقدية، بل سنتبع خطى كونديرا في فن الرواية، والذي لم يضعه إلا كعمل تأملي، لا كعمل نقدي لفن الرواية، ولهذا دعنا نصوغ ذلك بطريقة أبسط حول ثنائية الذات الناقدة من جهة والواقع المعاش من جهة أخرى.
هناك طريقان لفعل ذلك النقد، وثالثهما الجنون
الطريق الأول: أن يقوم الناقد بتعديل داخلي، فينطلق من الذات إلى الخارج، وفق صيغ متعددة، وبتعبير ميلاني أوضح، هناك حيلة الإفساد الداخلي للذات، وللذوق، ضمن درجات متفاوتة يتحكم في درجتها حجم الانخراط في حفلة التفاهة، حتى يتحقق الانسجام الإنساني مع الخارج البائس، والمهترئ.
الطريق الثاني: هو الخروج على هذا الواقع وتهشيمه، ثم إعادة صوغه بنحو يبدو صحيحاً ومعافى.
وبين هاتين الطريقين تقع منطقة الأحلام الأسطورية أو الخرافية، والتي قد تبلغ بصاحبها حد الجنون إذا ما قام الناقد بصناعة واقع افتراضي متخيل وموهوم ثم سكنه ذلك الناقد طوعا، أو لنقل احتبس فيه كحل وسط بين حلين كلاهما مر.
في الدون كيخوته يعيش الفارس النبيل هذا الحلم أولاً، وقد تمثله ثيربانتس من خلال الدون كيخوته وهو يقرأ آلافاً من كتب الفروسية وآدابها، والتي صورت الفارس كمظهر أعلى للنبيل البطل، القادر على تحقيق العدالة وهذا الفعل يمثل تبجيلاً للنظرية الثقافية أو المثالية كرائد للحل لكن الدون كيخوت لم يجد الحل في ذلك النحو، بل رأى انه حل يقترب به من الجنون، لهذا قرر الخروج عليه، واتباع الطريق الثانية، من خلال تهشيم الخارج وإعادة صوغه من جديد، وهنا تظهر الأحلام الواعية لثيربانتس، وتتكشف رؤاه النقدية فعالم الورق لا يصحح الواقع بل يعريه ويكشفه فقط.
والجميل جدا أن ثيربانتس بهذه البنية داخل الراوية قد حقق ثورة على فن الرواية نفسه، ضمن ثورته النقدية الكبرى، فأتت رواية الدون كيخوته كناقض لمسلك أدب الفروسية الهزيل والذي ينفخ صورة البطل الأسطوري ليعوض من خلال بطولاته التاريخية هزائم الواقع، وقد تجلى هذا النقد عبر السخرية اللاذعة والمرة، مقابل التبجيل لأدب الفروسية الذي سطرته الروايات وكتب التاريخ السالفة، وهنا تحديدا يكمن التوازن الخطير الذي لعب عليه ثيربانتس وهو يصوغ شخصية الدون كيخوته، وأقصد تحديداً اتباع الطريقين السالفين والتنويع بينهما في طول مسيرة الرواية، دون الوقوع في فخ ترسيم صورة المجنون للدون كيخوته، ولهذا السبب استطاع ثيربانتس ان يبلغ بالفارس النبيل كيخوته ذروة العالمية، حتى صيّره شخصية اسطورية ملحمية، أو لنقل بأنه جعل من كيخوته مرجعية في الإصلاح عبر تصحيح أدوار الفروسية والبطولة الورقية والأسطورية
إذا عرفنا هذه الزاوية بوضوح، فسوف يمكننا أن نتعرف إرث ثيربانتس ومدى أهميته، مما يتيح لنا الانفتاح مع كونديرا على سر الاحتقار لهذا الإرث بالغ الأهمية.
ولنبدأ من فن الرواية نفسه
ثيربانتس ثائر حقيقي في روايته ”الدون كيخوت“ لأنه هشم القناع الروائي التكراري كما يعتقد كونديرا نفسه، وتوضيحه أن الرواية في زمن ثيربانتس كانت تمر بفترة أفولها وموتها الحقيقي، حيث يميز كونديرا بين ثراء الإنتاج ونوعية المنتج، فالثراء لا يعني خلود الرواية ولا حياتها، حيث لا يقاس تاريخ الرواية ومجدها بكم المطبوعات منها، وإنما يقاس بنوع ما تقوله الرواية، وما تشتغل عليه، فثيربانتس في الدون كيخوته قد حارب كل أشكال القهر والحرمان والتسلط مستهدفا تشييد قيم جمالية أصيلة، وهي قيم تم الفتك بها على يد القيم الهجينة التي بشرت بها الأزمنة الحديثة، ولهذا يتمثل الدون كيخوته ذلك النموذج الذي تتهشم معه منظومة القيم الجميلة، ويقوم بإعادته والتذكير به كلما اصطدم بالواقع، مما يجعل القارئ مستهاما وحالما بتكرر ولادات لا منتهية للدون كيخوته، ذلك الفارس النبيل، مقابل الواقع المرير والهجين الذي تبشر به الأزمنة الحديثة ذات النزعة العلموية، والتي نقلت الإنسان من موقع سيد الكون إلى موقع الشيئية التافهة.
إن وظيفة الرواية عند ميلان كونديرا هي استكشاف الإنسان، واستعادة كينونته المنسية أو المتلاشية.
الرواية عند كونديرا عليها أن تقول ما لا يمكن قوله، أو ما لا يمكن إعادة حكيه، لا أن تقوم بعملية تناسخ فجة، وتافهة، تعتمد منطق التكرار، وتتحايل بلغة التشويق الرخيص، فهذا ليس نمواً لفن الرواية، ولا هو مادة صالحة لقياس عمر الرواية وتاريخها، ومن هذا المنطلق تحديدا يقف ميلان كونديرا على الرواية التيمة، أو الرواية المنعرج، والتي شكلت انكسارا أو انعطافاً لفن الرواية الحقيقية، والتي لا تقوم على مجرد العبث السردي.
في عقلية ميلان كونديرا وفي تأملاته خلاصات منها أن على الرواية أن تكتشف وتوضح وتضيء مختلف تجليات الوجود بكل تمظهراته، ولهذا نجدها مع ثيربانتس تساءلت عن حقيقة المغامرة، ومع صامويل ريشاردسون قامت بفحص الأشياء الداخلية، من خلال تعرية الحياة الخفية للأحاسيس، ومع بلزاك تم اكتشاف تجذر الإنسان في التاريخ، ومع فولبير اكتشفت الأرض، والخفايا اليومية، ومع تولستوي سعت الرواية لاختبار اللامعقول، وتجربته ضمن القرارات والسلوك الإنساني، ومع مارسيل بروست تم اكتشاف، واضاءة اللحظة المنفلتة، وأتى جيمس جويس ليضيء لنا اللحظة الراهنة، ومع توماس مان اكتشفنا دور الأساطير التي قادت مسيرة الإنسان في خطاه التاريخية والحاضرة، أو لنقل أنها درست قرارات الإنسان منذ اعمق لحظة زمنية ممكنة.
هذا هو تاريخ الرواية الأوربية، ولا يتمثل تاريخها في أرويل على سبيل المثال رغم روعته وبراعته؛ لأن كتابةً تنبؤيةً ستكون اجدى لو صيغت في بحث أكاديمي ضمن أرقام إثباتية، وبتعبير آخر فإن رواية ”1984“ لأرويل لا تبحث عن تلك الكينونة المنسية، ولا تذكرنا بها، وإنما تذكرنا بتفاقم النسيان الآتي، فترزع فينا رعباً مضاعفاً، وخوفا يابساً، ولا تحرك فينا حلماً يتوق للجوهر الإنساني بقدر ما ترينا تغول السياسة، فرواية أورويل لا تحمي كينونتنا المنسية، كما أنها لا تستعيدها.
وماذا أكثر من ذلك؟
يقرر ميلان كونديرا وبوضوح تام بأن فن الرواية وروحها هي روح التعقيد، فكل رواية تخاطب قارئها وفقا للمقولة التالية ”إن الأشياء بالغة التعقيد وهي ليست بالسهولة التي تظن“
هذه هي الروح الأبدية للرواية، والتي يتم تهشيمها عبر أجوبة تبسيطية للأشياء،
ولكن ما العيب في التبسيط؟!
التبسيط في جوهره معقد جداً لأنه يقوم بإلغاء السؤال وتهميشه، عبر تتفيهه وذلك من خلال اتباع تقنية تتفيه وتبسيط الإجابات.
دعنا نسأل سؤالاً وننظر ماذا سيتهشم معه عندما نمارس عليه العملية التبسيطية، لنسأل مثلا عن المرأة الجميلة من تكون؟
الإجابة التبسيطية ستأتي من دور عرض الأزياء والتي أسست لنا مقاساً موحداً لطول الشعر، ولون البشرة، وتقسيم الشفتين، واستدارة الردفين، ومقاس الصدر، و...
هذا الجواب التبسيطي لم يفتك بالسؤال ”من هي المرأة الجميلة؟“ فحسب، بل فتك بالمرأة ذاتها، أي أنه فتك بالإنسان فحوله إلى كينونة منسية لأنه بات مجرد شيئ فأي فرق حينئذٍ بين مواصفات جمال السيارة ومواصفات جمال المرأة ما دام الكل مقيسا بطريقة باردة؟!،
إن الرواية الحقيقية لها وظيفة محددة وهي استعادة هذه الكينونة وتذكيرنا بها، ولهذا تأتي الرواية معقدة عصية على فهمنا التبسيطي الساذج والتافه، يقول ميلان كونديرا: أننا مادمنا قد أجبرنا على حفلة التفاهة ”أي الإجابات التبسيطية المختزلة“ فمن التفاهة أخذ هذه الحياة على محمل الجد
مادامت الأفكار الكبرى تشق طريقها عبر تغريدة ببضعة حروف، فمن البلاهة أخذها على محمل الجد؛ لأنها تبسيطية اختزالية، ومن البلاهة أكثر أن تأخذ وعلى محمل جاد بضعة ثوانٍ في سناب مختزل لتفهم من خلاله تعقيدات الحياة، وهكذا الكثير الكثير من الأجوبة والأدوات التبسيطية الاختزالية.
إن تناسي الكينونة الإنسانية ليس وليد اللحظة، بل له عدة قرون سالفة وتحديداً بدأت عملية انقراض الكينونة تتسارع مع جاليليو والفتح العلمي؛ فعندما بدأ الإنسان يعيد وعيه بذاته على أساس غير إنساني، أعني ذلك الأساس المشترك بينه وبين الطبيعة، فأصبح مادة علموية مقابل المادة الإلهية أو الإنسانية سنجد أن تلك المادة العلموية التي أعاد الإنسان وعي ذاته من خلالها قد هشمت عرشه، فأنزلته من عرش ملك الكون إلى مجرد شيء من أشياء هذا الكون الفسيح، وتسارعت تلك الوتيرة، لكنها في عصرنا الراهن بلغت ذروتها، كما يقول كونديرا: " صحيح أن أرضات الاختزال تقرض الحياة الإنسانية منذ أمد بعيد: فحتى الوجد تم اختزاله إلى هيكل ذكريات هزيلة، غير أن ميزة المجتمع المعاصر تكمن في تقوية هذه اللعنة، وببشاعة، فقد تم اختزال حياة الإنسان إلى وظيفته الاجتماعية؛ اختزال تاريخ شعب ما إلى وقائع بسيطة، والتي طالتها هي الأخرى تأويلات مغرضة، كما تم اختزال الحياة الاجتماعية إلى الصراع السياسي، وهذا الأخير تم اختزاله إلى مجرد مواجهة قوتين عظميين.
هكذا يجد الإنسان نفسه في دوامة حقيقية للإختزال وكلما أراد الخروج منها أُركس فيها بإرادته.
لو نظرنا في كل اشتغالات كونديرا الروائية والتأملية فسوف نلاحظ بأنه لا يغيب هذا الشاغول المركزي أبدا، لهذا لم يكن استحضاره لهوسرل واستحضار نقد هذا الأخير فيما عرف بأزمة العلوم الإنسانية في أوربا إلا تموقعا في قلب السؤال، ورفعاً لوتيرته الجادة، مقابل العمليات التبسيطية والاختزالية.
فهوسرل عندما يتحدث عن أزمة العلوم الإنسانية في أوربا وتحولها للإطار العلموي البحت، والذي يحاول فهم الإنسان من منظور الشيئية، إنما يشير بذلك إلى فكرة تكريس الإجابة الاختزالية التي تعلمتها أوربا بسبب الموجة العلمية التي اكتسحتها، فباتت العملية الاختزالية والتبسيطية مثلها مثل التاريخ الاختزالي الذي يحكم على شعب كامل أو أمة كاملة من خلال لحظة واحد كتاريخ القصر أو تاريخ الإنجاز، مسقطاً كل الكينونات المتنوعة التي صنعت التاريخ والحدث في منطقة الهامش.
إن العلوم الإنسانية عندما سعت لبناء البرادايمات الثابتة تحولت إلى إيديولوجيات مغلقة، وباتت ذات وظيفة تنميطية اختزالية، وعلى الرواية وفنونها أن تكافح ضد هذا التنميط، كما وعليها أن تستعيد مكانتها عبر التذكير المستدام بالكينونة المنسية، من خلال إعادة الاعتبار للإنسان، ولو أردنا ان نتعمق مع كونديرا أكثر فأكثر فعلينا أن نقرأ معه ما يقوله " إن روح الرواية هي روح اتصال، فكل أثر يشكل جوابا للآثار التي تقدمته، كل أثر يختزن كل تجربة سابقة على الرواية، بيد أن روح عصرنا ترتكز على الراهن المترامي الفسيح الذي يتمادى في رفض ماضي أفقنا، كما يعمل على اختزال الزمن إلى اللحظة الراهنة الوحيدة، فالرواية كونها مضمنة في هذا النسق ما عادت تشكل أثرا «أي ما عادت شيئا قابلاً للدوام وقادراً على وصل الماضي بالمستقبل» بل صارت حدثا راهنا كالأحداث الأخرى، حركة لا غد لها.
نحن لو نظرنا لهذه العبارة بتدقيق وتشريح كافيين فسوف نجد أن اختزال الزمن في لحظة واحدة هو سر السقوط وانعدام الأثر والديمومة، فالتاريخ لأنه كتب عن لحظة واحدة، وهي اللحظة الماضية، متخذاً من سلطة القصر المتصرمة مادة له فقد قدرته على المسير والتأثير، وهكذا الحال بالنسبة للدين بصورة إجمالية وذلك عندما تم اختزاله من قبل شراحه في لحظة آتية ممثلة في يوم الخلاص فقد قدرته على التأثير في حياة الناس الراهنة، ولو أردنا أن نستعير تعبيراً دينيا لهذه الحالة فسوف نسميها بالدهرية الإلحادية،
العلم الذي اختزل الكينونة في اللحظة الراهنة لن يدوم في أفق الإنسان، فهذا الإنسان لا يمكنه أن يعيش بلا ذاكرة، والذاكرة لا تبنيها السرعة والانخطاف كما يؤسس لها الحاضر التافه فهذه اللحظة سيملها ويمجها الإنسان، ولذا لابد له من البطء، وهذا البطء يتنافى مع الاختزال الخاطف والسريع المؤسس بسرعته الفائقة للتفاهة، مما يعني ضرورة التأمل والتدقيق لاكتشاف الأسئلة المعقدة في سبيل التعريف بالكائن وكينونته، من أجل إعادة الثقل إليه مقابل هذه الخفة اللامتناهية للوجود كله.
وبتعبير ختامي فإن هذه الأزمنة السائلة قضت على كل المفاهيم المرجعية وفتكت بكل قواعد الفنون، مما تسبب في خلق فردانية مشوهة تركت الإنسان عارياً وحيدا في مواجهة الحياة المعقدة بعد أن أغراه الساسة وتجار المفاهيم من خلال خديعة الأجوبة التبسيطية والاختزالية بسهولة الحياة وتفاهتها.
لقد ساقوه كما تساق الشاة لذبحها، مما جعله يمل حياته، ولو شئنا أن نصف هذا الفعل التشويهي من زاوية سيكيولوجية نفسية، فسوف نقرر بان الملل هو المصدر الوحيد لاختيار الموت طوعا، وذلك أن الإجابات التبسيطية المقترحة علينا تشكل حاجزا حقيقيا عن العبور نحو تعقيد الواقع مما يعني أنها تمنعنا من الانفتاح على العميق والدقيق وهي تحرمنا بذلك التبسيط والاختزال من متعة التحدي وبهذا فإنها تدفعنا بكل شراسة وقسوة نحو الملل لنقع فريسة اختيار الموت، وعبر أشكال متعددة لممارسة الموت حتى بلغنا لحظة الاستمتاع بسادية العنف والموت فتقرأ المذيعة خبر موت الالاف بشفتين باسمين، والسبب هو تخلق الملل من رحم السيولة وتبسيط مفهوم الوجود عامة، وتبسيط وتسييل مفهوم الإنسان خاصة، فما دام هذا الإنسان مجرد شيء من أشياء الكون الفسيح فعليه أن يغرق ويسرف في صنوف الموت من مخدرات، وانتحارات متنوعة، بل إنه بات يسأل بطريقة استنكارية عن سبب احترام حياة الآخر ما دامت تافهة وبسيطة، ولهذا لا يجد بأساً في الإقدام على العمليات الانتحارية فيقتل بني جنسه ممن لا ذنب لهم سوى أنهم مملون وتافهون بنظره كما يقتضيه هذا التبسيط الممل ولم يعد برى بأسا في ترويج المخدرات وأصناف البذاءات والتفاهات كلها.
إن الإرث المحتقر لثيربانتس هو هذا المسير الأعمى نحو تشيئة الذات مع الاستمتاع التام بهذا المسير والانغماس إلى درجة ان الذات باتت تشعر بالنقص كلما نقصت حولها الأشياء، فيتخلق الملل والسأم بمجرد أن يفقد الإنسان جواله الذي يتصل من خلاله بالأشياء، ولم يعد هذا الشيء المسمى بالإنسان قادرا على الاتصال بذاته أبدا، بمعنى انه أصبح ينمي الذات المشيأة مقابل ذاته الوجدانية حتى وصل معها إلى لحظة العجز عن الإحساس بأناه وذاته دون اتصال بالأشياء وكأن هذه الأشياء أنابيب أكسجين متى رفعت عن هذه الذات خبت وماتت وتعود فيها الروح بعودة الاتصال بها مجددا مما يجعل الحياة رحلة بل رحلات مكرورة من الموت والحياة ويقع كل هذا ضمن حياة وهمية تمت مخادعتنا بها بعد أن ضخ ساسة المال ومال السياسة في هذا الوهم روح المال الأعمى فصارت عبر ماليتها حقيقة عليا وصار الإنسان الخارج عنها أو المتمرد عليها هو الوهم والخرافة.
هكذا صارت كل خرجات كيخوته بلا فائدة وغدا إرثه محتقرا فالناس لا تريد إلا كتب الفروسية التي يمجد فيها البطل الموهوم ولا يسعها أن تعيش الحياة المعقدة لهذا تختار الأجوبة التبسيطية المختزلة كلما أتيح لها حق الاختيار.