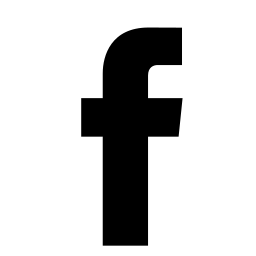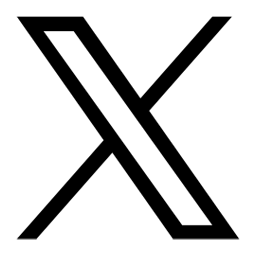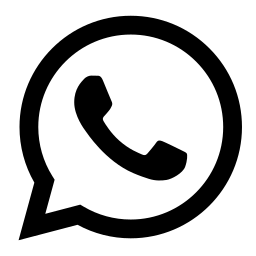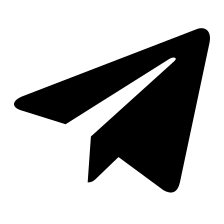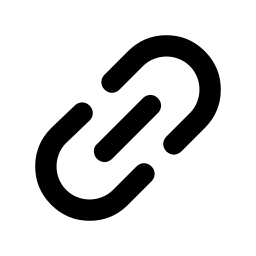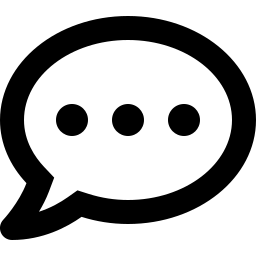الأدب بين وحدة التصور وأسبابه
مَن يتصفح منكم أغلب الموسوعات الأدبية يلاحظ في تعريفاتها اقتران الأدب بالمتعة، باعتبار الأخير عنصرًا جوهريًّا في استمرار الأدب عبر عصور التاريخ.
وأضاف المؤرخون والنقاد أسبابًا أخرى تختلف طبيعتها باختلاف تصوراتهم عن الأدب نفسه، وكذلك باختلاف طبيعة الثقافات المرجعية التي ينتمي إليها كل مؤرخ أو ناقد أو مبدع، فالتصور عن الأدب في السياق الثقافي التاريخي الإسلامي يختلف عنه بالتأكيد في السياق الثقافي التاريخي الغربي، ولن تقصر أيدينا عن الأدلة والشواهد العديدة، في كلا السياقين، إذا ما أردنا أن نفصّل أكثر في هذه الفقرة من الموضوع. لكنني أريد الانتقال في الحديث عن مفردة الأدب الواردة في السؤال مقرونة بفعل القراءة.
أولًا: هناك في الثقافة المعاصرة ما يشبه الإجماع على وحدة التصور للأدب عند أكثر المتابعين والمحللين، تحت مصطلح ما يسمى بالأدب العالمي.
ثانيًا: وحدة العيش المشترك بين البشر هي إحدى الروافع الكبرى التي تنهض عليها تصوراتنا الحالية للأدب، وهذا يعني فيما يعنيه، إنتاج قيم مشتركة توحّد التجربة الإنسانية، وتتيح للإنسان فرصة المقاومة ضد كل أشكال العزل والتسلّط والكراهية والإلغاء والقبح في العالم، فمحاولة فهم الحياة والعالم والطبيعة على أساس سبر أغوار عوالم الحب والموت والوجود والقلق والمرض والعقل والمخيلة، هي من الوظائف الكبرى التي تختص بالأدب والأدب فقط.
ثالثًا: إذا كان الأدب في النظرية المعاصرة هو فعل تخييلي بالدرجة الأولى، فإن الشعر والرواية والقصة والمسرح والموسيقى والسينما، وكل أشكال الرسم هي مقوّمات هذا الفعل، حيث لا ينفك يغذي الواحدُ الآخرَ منها، رغم التفاوت في الطبيعة والموقع والتوجه.
فالتجاور والتواصل بين هذه الفنون الأدبية وفعاليتها أعطى للثقافة المعاصرة سمت الوحدة من العمق، بينما أعطاها التراكم المعرفي والعلمي على السطح سمت التشتت والعمى والعزلة، وهذه إحدى المفارقات الكبرى التي يسعى الأدب في لحظته الراهنة إلى مقاومتها، وبعنف تخييلي في أغلب الأحيان، كرد فعل عكسي لما يجري في العالم.
رابعًا: دعوني أوضح ما المقصود هنا بالمفارقة، وما علاقة الأدب بها؟
حين دخلت التقنية والتكنولوجيا حياتنا المعاصرة، وأصبحت جزءًا من التفكير الإنساني، وصارت تحكم الطوق على العلاقات الإنسانية شيئًا فشيئًا منذ ما يقارب القرنين من الزمن، وأثرت بالتالي على مجمل مسار المعرفة ودروبها، كان العلم وخطابه يمثل سلطة مؤثرة على العلوم الإنسانية من فلسفة وعلم اجتماع وعلم نفس وتاريخ، وكانت تقاليده وتصوراته للإنسان والحياة والطبيعة جرت مجرى الدم في عروق مختلف فروع العلوم الإنسانية، فأصبحت الفلسفة تطمح لأن تكون علمًا، كما أقدم الكثير من فلاسفة العصر، وكذلك علماء الاجتماع بشتى فروعهم سعوا إلى الاقتراب من مفهوم المختبر، وفق مكانته التي يحتلها في الخطاب العلمي، وهكذا تعددت النظريات المتأثرة بهذا المطمح، وفق تعدد الحقول المعرفية، وما زاد الطين بلة، هو التشعّب الكبير الذي أدخلت العلوم الإنسانية نفسها من خلاله تحت ما يسمى بالتخصص الدقيق، فقد يقضي باحث علمي في حقل الذرة ما يناهز الأربعين سنة في مختبره كي يكشف سر حركة الإلكترون، كما يقضي باحث آخر في حقل الإنثروبولوجيا المتفرع من حقل الدراسات التاريخية أيضًا أربعين سنة يدرس لغة أقوام وطبائع متوحشين لم يدخلوا الحضارة المعاصرة من أبوابها، كالقبائل المتعددة في البرازيل وهكذا.
خامسًا: هذا الوضع خلق مساوئ عديدة إزاء إيجابيات التطور، من أهمها انقطاع التواصل بين الناس، وكأن المعرفة العلمية والإنسانية نسجت حول الإنسان المعاصر أفعى العزلة وأسلمته إلى لسعاتها القاتلة، ودمرت في داخله غريزة الإحساس المباشر بأشياء الطبيعة، والإحساس العفوي بالشعورالإنساني، وعلى الرغم من القدرة الفائقة للتكنولوجيا في تحطيم أسطورة الزمن التي هي المسافة، بيد أن ذلك عمّق المأساة أكثر، ولم ينجُ من ذلك مجتمع أو أفراد.